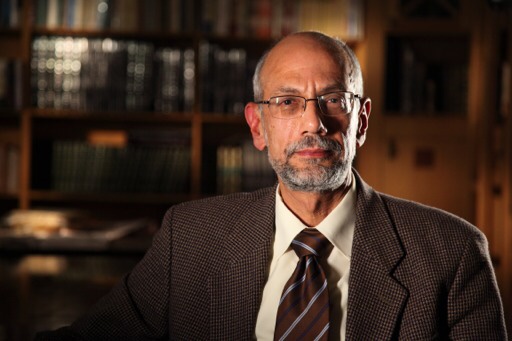مثلى، قد تتفق أو «تختلف» مع بعض ما ذهب إليه «الأستاذ» من «آراء»، ولكنك لا تملك أن تختلف مع حقيقة أن رجلا ــ لم يرفع غير قلمه سلاحا
مثلى، قد تتفق أو «تختلف» مع بعض ما ذهب إليه «الأستاذ» من «آراء»، ولكنك لا تملك أن تختلف مع حقيقة أن رجلا ــ لم يرفع غير قلمه سلاحا ــ حاربته دول وجماعات، وحاربه ملوك ورؤساء.. فهل هناك دليل على «قيمة الكلمة» أكثر من ذلك.
مدركا حقيقة أن كلنا فى النهاية ذاهبون، ولا يبقى من كل منا من أثر غير ما عمل أو قال أو ــ بحكم المهنة ــ «ما كتب»، آثرت ألا أكتب «كغيرى» عن الرجل، بل عن قلمه «وما كَتب». فللرجل مع الكلمة باع، وتاريخ.. «وأثر»، ستون كتابا، ومقالات لا حصر لها، وحوارات ولقاءات ووقائع تحقيق: أمام المدعى الاشتراكى (صيف ١٩٧٨،) ثم أمام رئيس هيئة الفحص والتحقيق فى مسألة أموال مبارك المهربة (مايو ٢٠١١). وأحسب أن فى سطور ذلك كله، وعباراته المكتوبة أو المنطوقة «رسائل لم تصل».. وأخشى أنها مازالت «لم تصل» إلى من يهمه الأمر.
علي طاولتي «بقلم محمد حسنين هيكل أو بصوته» نصُ محاضرةٍ في معرض الكتاب (١٩٩٥)، ومقالٌ في «وجهات نظر» (يونيو ٢٠٠٠) تحت عنوان «حديث مستطرد عن السياسة الداخلية»، ثم نص لمحاضرة الجامعة الأمريكية الشهيرة (أكتوبر ٢٠٠٢). ثم شريطان مسجلان لحديثين؛ أحدهما في «قناة الجزيرة» في يونيو ٢٠٠٥.والثاني في قناة CBC في أبريل ٢٠١٥ وأخيرا كتابه الأخير (من جزئين) عن «مبارك وزمانه .. وما بعد زمانه».
……………….
قبل أسابيع من رحيله، وعكس عادته التي نعرف في ترتيب مواعيده بدقة لا تسمح بتداخل أيها مع الآخر، كان أن رتب الأستاذ ما «قد لايبدو مرتبًا». يومها، كنت في مكتبه (مع الصديق محمود سعد) في زيارة حدد موعدها بنفسه. ثم كان أن جمعنا، على غير ما توقعنا بزائر «تقاطع موعده». وهو أحد أكثر الرجال النافذين في كواليس القرار هذه الأيام. وفي شرفة مكتبه المطلة على النيل، والتي أعلم قدر من زاره فيها من الشرق والغرب، ولساعة أو أكثر، قبل أن ينضم إلينا آخرون طال الحوار الذي يمكن لكم أن تتوقعوا «سخونته» .. ولعل ما دار في لقاء «الصدفة المرتبة» كان رسالته «الواضحة» الأخيرة. ولكنها لم تكن أبدا رسالته الأولى «لمن يهمه الأمر».
فقبل عشرين عاما كاملة، وفي محاضرته «الاستثنائية» في معرض الكتاب (لم يُدع بعدها أبدًا)، يذكر من حضر المحاضرة أو سمع بها كيف لخصَ هيكل أو لعله شخَّص حال مصر أيامها في عبارة شاعت وصفا وتلخيصا: «سلطة شاخت في مواقعها..». وأمام حشد غير معتاد في مثل تلك المحاضرات، بدأ حديثه يومها بمحاولة توصيف الأحوال في مصر توصيفًا موثقا وبالأرقام. ملاحظًا أنه «ومع أن كل الناس يستطيعون ملامسة الحقيقة في معايشتهم لحياة كل يوم، فإن هناك إلحاحا زائدا عن كل حد لتلوين الصور وتزويقها».
اقتصاديا عاد هيكل في توصيفه يومها للأحوال في مصر إلي أرقام رسمية مأخوذة من مراجع معتمدة أولها مرجعية البنك الدولي. لينبه إلي «حقائق اجتماعية تتصل بهذه الحقائق الاقتصادية وتترتب بالضرورة عليها». منها أن البطالة في مصر زادت زيادة مخيفة والأخطر أنها تنتشر بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة وهي «كتلة تعلمت وتهيأت للعمل في بلد يعتبر التعليم فيه وسيلة وحيدة للصعود الاجتماعي». ويعني ذلك في نهاية المطاف أنها بطالة مدركة واعية قابلة لأن تتحول إلي شحنة غضب عارم يشعر أن مجتمعه يسلبه حقا كان يحسبه في انتظاره. (بالمناسبة كانت مانشتات الصحف أيامها (١٩٩٥) تتحدث عن وعد رئاسي بتوفير 5،4 مليون فرصة عمل في السنوات الست «الرئاسية» القادمة. في حين كان خبر في صفحة داخلية يتحدث عن أن مسؤولي إحدي المحافظات حين نشروا إعلانا يطلبون فيه «خفراء للمقابر» يعرفون القراءة والكتابة، فوجئوا أن من بين المتقدمين ألفًا وخمسمائة من خريجي الجامعات، أحدهم يحمل درجة الماجستير
يومها أيضا صدم هيكل مستمعيه «قلقًا علي مستقبل الاستقرار الاجتماعي في مصر» بعرض تقرير وضعته مجموعة دولية عن المؤشرات الطبقية الجديدة في مصر، مقارنا بين قمة الهرم الاجتماعي الضيقة شديدة الثراء، وقاعدته الفقيرة شديدة الاتساع، متخوفا «أننا أمام وضع لا مفر من التسليم بأنه بالفعل مخيف لأن النار قريبة من الحطب بأكثر مما تحتمله سلامة الأحوال في مصر»، وملاحظًا أن هناك «حالة من خلل التوازن راحت تعتري المجتمع المصري وتهزه بقسوة .. وأن هذا التناقض الحاد بين الفقر والغني سبب شعورا بالاستفزاز يصعب تجاهله، خصوصا وقد بدا تركيز الغني غير مبرر، وأيضا غير مشروع. ثم إن حصار الفقر بدا هو الآخر غير مبرر وغير شرعي».
وبعد أن يرصد ما جري للطبقة الوسطي في مصر، يعرب هيكل يومها عن قلقه لجموح أسباب العنف وموجباته. فالسلام الاجتماعي في أي وطن ليس مسألة حض علي فضيلة الصبر، وليس مسألة نص قانوني يغلظ العقوبات علي مخالفة مواده.. «إنما السلام الاجتماعي مطلب مركب، وهو مشروط بشرعية السلطة، مشروط بمشروعية الثروة، مشروط بحقوق المواطنة، مشروط بإحساس المساواة بين الناس وإن تفاوتت الكفاءات أو حتي الحظوظ..».
حديث الاقتصاد، والذي هو في التحليل النهائي انعكاس السياسة علي حياة الناس اليومية، لم يغب عن مقال هيكل في «وجهات نظر» (يونيو ٢٠٠٠) عن «السياسة» في مصر. والذي أشار فيه إلي ملاحظات مقلقةٍ عن المناخ الذي تتوالد فيه ظواهر منها ما هو دعائي لا يغني ولا يسمن من جوع، ومنها ما يعمل وإن ببطء علي تآكل تماسك هذا البلد وحيويته:
١ـ أن أرقامًا غير دقيقة يجري ترويجها، بجرأة بالغة … ولهذا مخاطره مهما كان إغراء الأرقام البراقة. «إذ تَتَحَوَّل إلي نوعٍ من خداع البَصَر».
٢ـ أن حديث المشروعات العملاقة ملأ الدنيا وشغل الناس، وصعد بسرعة إلي رأس قائمة الأولويات، وفي الصدارة منه «مشروع توشكي».. والذي تبين لاحقا أيضا أن إغراء التصريحات البراقة حوله كان غالبا.. وربما خادعًا.
٣ـ أن ظاهرة تفاقمت في الحياة الاجتماعية المصرية، وتمثلت في تكالب علي الاستهلاك «مُتَوَحِّش»، بدت بعض مظاهره في أفراحٍ تتَكَلَّفَ ما بين مليونين إلي خمسة ملايين من الجنيهات وبينها ما زاد علي ذلك وأحياناً بكثير!
٤ـ أن سباقا موازيًا بدا علنيًا لتخاطف أموال النظام المصرفي والحصول علي أكبر ما يمكن الحصول عليه منها، وتحويله إلي الخارج.. ثم الهرب.
•••
لم تكن رسائل هيكل «المبكرة» والعلنية عن مناخات اقتصادية هي بالضرورة مهددة ليست فقط للسلام الاجتماعي، بل وللنمو الاقتصادي ذاته هي الوحيدة التي لم تصل «إلى من يهمه الأمر»، إذ بدت «رسائل السياسة» التي تواترت بعد ذلك أكثر قابلية للإزعاج … والتجاهل.
يدافع هيكل في «الجزيرة» ـ ٢٠٠٥ عن «تغيير بات ملحًا». ويرد علي الذين يرفضونه بدعوي «الاستمرار والاستقرار» بالتأكيد علي أن «الاستقرار الحقيقي هو مسايرة متغيرات الزمن» مشيرا إلى مجموعات المصالح «المتشابكة» التي تستولي بسلطتها أو بنفوذها علي الإدارة ثم علي الحكومة ثم علي الدولة كلها. محذرا من مناخ يعمل على نمو ظاهرة أسماها «One Man Show»،
حديث «التغيير الملح» هذا كان قد مهد إليه بمقال في «وجهات نظر» ـ يونيو ٢٠٠٠ منبها إلى خطورة أننا في عالمنا العربي ورغم وجود ما أسميناه أنظمة جمهورية، نتحدث في واقع الأمر عن «الولاية» ولا نتحدث عن الإدارة، وهنا المشكلة. اذ أن تلك مفاهيم تنتمي لزمن لم يعد يعيش فيه أحد. ولم تعد تصلح في أزمنة الدساتير والقوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الكبري ، وفي أزمنة جري فيها ترويض أعتي الأنظمة الملكية، ووقع إرغامها علي أن تضيف «الدستورية البرلمانية» لاحقة بالملكية في الوصف وسابقة عليها في الحقيقة! ثم قضت علي الملكية أن تكون محصورة في المراسم لا تتجاوزها إلي سلطة الحكم.
إذ إن العالم «المتقدم» ينبهنا هيكل يعرف ويتصرف علي أساس أن السلطة تفويض مؤقت من شعب يملك الولاية بمعني السيادة في حوزته، ثم هو يُفَوِّض بالانتخاب الحُرِّ بعض تنظيماته وأفراده بإدارة شئونه السياسية، مُتَعَرَّضين طول الوقت للحساب باعتبارهم «إدارة لا ولاية». وهكذا فإن الكل:
ــ يُحاوِر «الإدارة» وبالشدة أحياناً كما حدث للرئيس «كنيدي» بعد محاولته الفاشلة لغزو كوبا سنة ١٩٦١.
ــ ويُعارِض «الإدارة» كما حدث للرئيس «جونسون» بسبب حرب فيتنام.
ــ ويُحاكِم «الإدارة» كما حدث للرئيس «بيل كلينتون» بسبب تصرفات شخصية تجاوز بها حدود اللياقة ولو لم يتجاوز حدود القانون في قضية «مونيكا لوينسكي».
ــ ويعزل «الإدارة» كما حدث للرئيس «ريتشارد نيكسون» لأنه خَدَعَ الرأي العام الأمريكي وكذب عليه كما حدث في فضيحة «ووترجيت»!
•••
رغم أهمية «ووضوح» الرسائل التي لم تصل (ولعلها لم تصل بعد) في ١٩٩٥، و٢٠٠٠، ٢٠٠٥، ربما كانت محاضرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ــ أكتوبر ٢٠٠٢ هي الأكثر أهمية إذ ربما ـ كما أشرت هنا من قبل ـ لم تكن فقط «الكلمة» الأولى التى تُنَبه مبكرا الى خطورة مشروع التوريث الذى كان، بل لعلها قدمت، ومبكرًا أيضًا إطارا «فكريًا» وضروريًا لفهم حركة التاريخ «والشرعية» فى بلادنا. وكيف أن قصورا فى فهم، أو بالأحرى مواكبة هذا التطور الذى حكى عنه عالم الاجتماع الأشهر ماكس فيبر، أو «الاكتفاء بمظهره دون جوهره» كان سببا مباشرا فى انهيار نظام مبارك وحزبه، ومن بعده مرسى وجماعته، رغم اختلاف الألوان والمشاهد والظلال؛ حنكة وحمقًا، غرورا ومراوغة. بل لعلى لا أبالغ إن قلت أن قصورًا «نخشاه» فى فهم حتمية التطور تلك ربما يحكم أيضا نهاية أي نظام حالي أو لاحق، إن لم يع الدرس ويستلهم العبر.
يتحدث هيكل بوضوح عن «الديموقراطية التي لا ينبغي أن تتأخر» مهما كانت دعاوى أو حجج من اطمأن إلى وجودٍ في الحكم، أو من اقترب من وهج سلطة لا يريد لموازينها أن تتغير.
ففى الغد أحدُ احتمالين (والكلام هنا للأستاذ في محاضرته): إما صورة تتكرر بها الصور على نحو ما، أو انه، إذا صدق الوعد والعهد، باب مفتوح لتطور صحى تستقيم به الأمور وتستقر الحقوق … وفى محصلة ذلك ومغزاه ان مصر الآن ــ وليس غدا، فى حاجة الى رؤية للهوية أمينة، والى سند فى المرجعية أصيل، والى شرعية تؤسس لزمن، يستحيل قبوله امتدادا متكررا لشرعية الرجل الواحد، أو لدعاوى حزب مهما اعتبر نفسه ديمقراطيا.
ومن المحقق ان الوقت حان وزيادة، للانتقال الى الدرجة الأعلى فى مراحل الشرعية «الحقيقية». لأن مصر بكل ما حققت، تجاوزت، وينبغى لها أن تتجاوز، مرحلة الشرعية الأبوية التقليدية، إلى شرعية دستورية حقيقية
ثم منبها يومها الى «تحديات زمان جديد لا تحتمل إستراتيجية الانتظار وسياسة التأجيل»، يأخذنا هيكل عبر محاضرته الى عدد من الملحوظات، أهمها:
ــ أن مجرد التواجد فى الحكم ليس كافيا فى حد ذاته لاضفاء الشرعية على أى تنظيم أو نظام.
ــ أن المطلوب ليس نقلة من رجل إلى رجل وإنما من عصر إلى عصر ــ أى من شرعية تستوجبها الظروف إلى شرعية يتطلبها المستقبل. وبالتالى: من الفرد الى المجموع، ومن الحاكم إلى الدستور ومن الصورة إلى القانون.
ــ أنه لا مكان للارتجال. فالارتجال ثغرة ينفذ منها المجهول فى زمن لا يتحمل الثغرات، ولا ينتظر المصادفات ولا يقبل مناورة تؤخر جواب كل سؤال إلى الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة، ثم تضيع الفرص ومعها حق الاختيار.
•••
في كتابه الأخير، وأحاديثه التلفزيونية الأخيرة، كانت ربما رسائله الأخيرة:
عن التكامل والتناقض في ثنائية الأمن والأمان، ينبهنا هيكل إلى خطورة أن يصبح «لأمن» النظام وأمن الرئيس الأولوية على الشعور «بالأمان» الذي يمكن أن توفره سياسات عادلة اقتصادية وسياسية واجتماعية، لا احتكار فيها لسلطة ولا تمييز فيها لصاحب سطوة أو نفوذ. ويُذكرنا في كتابه الأخير «مبارك وزمانه ـ من المنصة إلى الميدان» بكيف أخذ هاجس الأمن «بالتنصت» على حياة الناس الخاصة ومحادثاتهم الهاتفية لأن يصبح «ثقافةَ نظام» (بعض من تلك التسجيلات وجدت طريقها أخيرًا إلى شاشات الفضائيات وصفحات الصحف). كما يُذكرنا بكيف وصلت هيستريا الولاء والإجراءات الأمنية أيام السادات مثلا (وهو ما تضاعف أيام مبارك) إلى درجة رصد «حوافز» ومكافآت خاصة لرجال الشرطة المكلفين بحماية موكب الرئيس. وأن تتميز هذه المكافآت عن غيرها بأن توضع في أظرف خاصة عليها شعار رئاسة الجمهورية، تُذكر من يتسلمها ـ ولو بالإيحاء ـ أنها من «ولي النعم»!! وكيف لم تفلح هذه الإجراءات في الحيلولة دون أن تضرب المقادير ضربتها يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ «بواسطة ضابط في القوات المسلحة، بيده رشاش من صنع روسي، وفي جيبه مسدس من صنع أمريكي!! (هيكل: مبارك وزمانه، ص: ١٧٦)
وكما عن هاجس الأمن، يحكي لنا هيكل أيضا في كتابه الممتع والمؤلم في آن، عن «هاجس البروتوكول» (ص: ١٩٩) وكيف أن الشكل لا الموضوع (وطول «البساط الأحمر») كان دوما الشاغل الأول لرجال الرئيس (!)
ثم كان في أحاديثه التلفزيونية الأخيرة أن ذكرنا بما نعرف من أن نظام مبارك لم يسقط بعد، داعيًا من صار في السلطة إلى «الثورة على نظامه».
وهو الحديث الذي كان من الطبيعي أن يفتح عليه نيرانا من نظام بدا قد عاد واستقر. كما بدا أن داخل هذا النظام من أراد مبكرا أن يدفع بقلم «الأستاذ» المؤثر إلى مربع الحياد، عبر رسالة إزعاج مبكرة بسؤال أمام «قاضي تحقيق» اهتم «بدقة» الأرقام التي هربها مبارك (لا بكيفية استعادتها). ثم كان أن طال التحذير مشاعر إنسانية يعرفها كل أب، مع حملات إعلامية بدت منظمة وإن اختفى منظموها.
……………….
ثم يبقى أنه فضلا عن أن هناك من اعتقد أن بإمكانه «تأميم» الرجل، فقد كان للأسف أن لحق بصاحب القلم ما لحق منطقتنا كلها من رياح «استقطاب» تعصف بكل رأي «آخر»، منذ انقلب صدام على العروبة بجريمة غزو الكويت (١٩٩٠) وحتى انقلب من انقلب في غير قطر عربي على «ربيع» حاول شباب العرب أن يغرسوا أزهاره في صحراء قاحلة تيبست أحجارها، وشخوصها، وقصورها. فنسي البعض ما كتبه عنه عبد الوهاب المسيري في مذكراته، وما كتبه عنه طارق البشري في وجهات نظر (أكتوبر ٢٠٠٣)، كما نسي آخرون ما قاله زمن مبارك، ثم تأييده المطلق لما جرى في ٢٥ يناير في كتابه الأخير عن مبارك وزمانه
•••
وبعد..
فقد كان الأستاذ، منذ أن كتب لقارئه رسالته الشهيرة «استئذان في الانصراف» (سبتمبر ٢٠٠٣) يحرص دائما على أن يؤكد على أن هناك جيلٌ يملك وحده المستقبل. وله وحده الحق في أن يقرر ماذا يريد لأيامه القادمة .. وأن يفعل.
أما نحن «فأيامنا خلفنا» كما قال غير مرة. وعليه، فليس لنا أوعلينا غير أن نقول «كلمتنا» ونمضي .. وقد كان.
……………….
في مسجد سيد الشهداء، في قلب القاهرة القديمة جالسين في انتظار صلاة الجنازة، تصادف أن كان بجواري شاب يبدو عشرينيا. ثم كان عندما تبين مجاورَه أن مال علي هامسا: «قل لمصر بالراحة علينا. لم نعد نحتمل».
أرجوكم، اقرأوا رسائل هيكل، وترفقوا بالمستقبل.
*ينشر هذا المـقـال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة