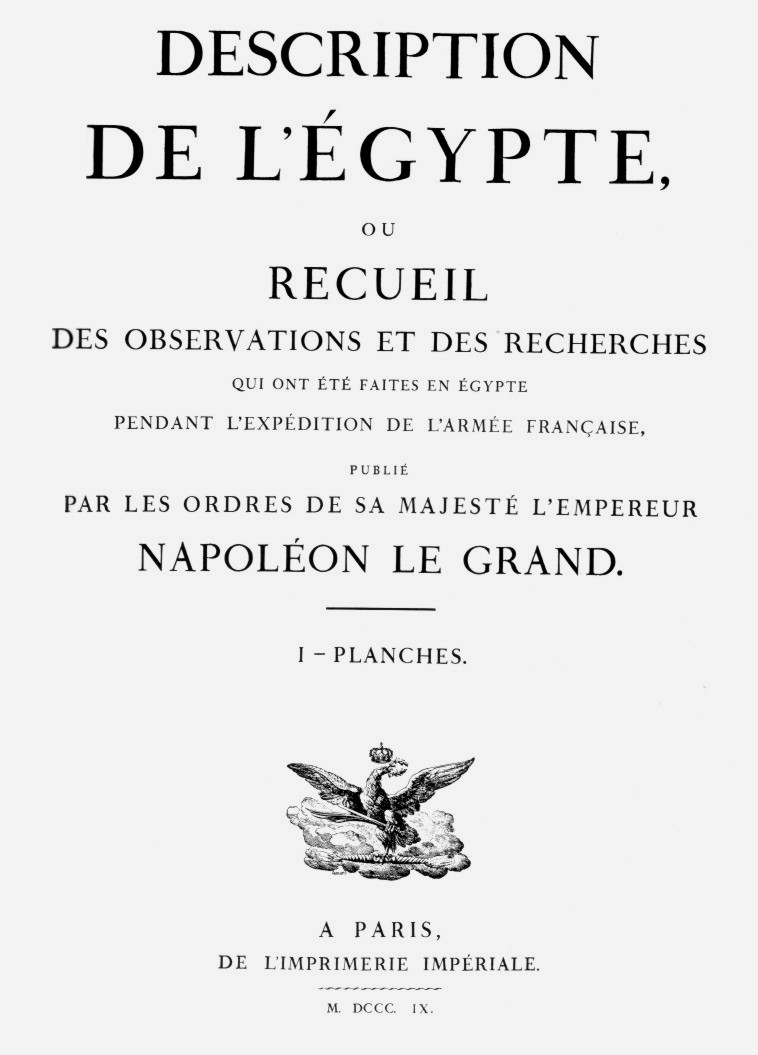واقعة تابوت الإسكندرية الأسود أعادت للأذهان لغز مقبرة الإسكندر الأكبر، وذاكرة المدينة التي تعد متحفاً حياً لتاريخ غارق في عشقها.
ثلاثية المعالم الحيّة والمندثرة والمختفية بالإسكندرية تحتضن خزائن التاريخ
سيمفونية بديعة تسكن مكان المنارة المندثرة، يلحنها الصراع بين الماء برقته والحجر بصلابته، وكأنهما حبيبان يتشاجران ويتصالحان
هنا دارت أحداث قصة حب «أنطونيو وكليوباترا» .. وهنا كان معبد الثقافة القديمة
الإسكندر استهدى في إنشاء مدينته الخالدة بتوجيه هوميروس في «الأوديسة» عندما أغاثت «فاروس» أبطال حروب طروادة
هواء بحر الإسكندرية ممزوج برائحة التاريخ، وتداعبه أنفاس الماضي، وكأن ذلك الماضي لا يزال حياً
مدينة «هرقليون» الغارقة .. متحف مفتوح تحت الماء
هنا الإسكندرية، مهد الثقافة وأرض التاريخ، حكايات العشق والأساطير.. رمالها باثقة بالآثار وخطى الأبطال، وبحرها تستوطنه الكنوز الغارقة.. أما هوائها فنسماته تعبق بشذى عطر «كليوباترا» وحبيبها «أنطونيو»، وقبلهما أنفاس الإسكندر الأكبر، بانيها الذي دان له نصف الدنيا، لكنه اصطفى أن يدفن في أحضان محبوبته، فاحتضنته، وأخفت سر مكان دفنه فيما يبدو إلى الأبد.
قصتها تجمع المأساة والأمل، فعلى الرغم من تعرضها لفيضانات وزلازل أغرقت ودمرت معالمها الأسطورية، إلا أن ذلك لم يمنع حكامها المتعاقبون من تشييد معالم جديدة، فنشأت ثلاثيتها الخالدة: (معالم راسية الآن على أرضها وفي بحرها، وثانية مندثرة مادياً باقية ذاكرياً، وثالثة مختفية حيرت العالم المتلهف لرؤيتها).
بين المعالم والشواهد الحيّة والمندثرة والمختفية، والحكايات التي يختلط فيها الواقع والجمال بالأسطورة والخيال.. كانت رحلة النبش والغوص التالية في رمال وبحر الإسكندرية، ومحاولة توثيق جزء هام من ذاكرتها التاريخية والثقافية.
المنارة والقلعة.. مشاهد تبهر العين وتناجي المشاعر
في بداية نهار يوم صيفي، طرقت أبواب قلعة قايتباي، باحثاً عن طعم ومذاق التاريخ هناك؛ فقد كانت تسكن المكان ذاته منارة الإسكندرية المندثرة، إحدى عجائب الدنيا السبع قديماً، أما الساكن الجديد الذي قصدته فهو من نسلها أيضاً، حيث تجري في شرايين القلعة دماء المنارة، لأنها بنيت ببعض أحجارها.
يتمتع الزائر لقلعة قايتباي بمشاهد ساحرة وخلابة، تبدأ في الترائي عبر نوافذ صغيرة أثناء الصعود للأعلى عبر الدرج الداخلي، حيث يجذبك مشهداً بانورامياً غير مكتمل لمياه البحر المتوسط، وهي تداعب صخور القلعة.
مع وصولك أعلى القلعة، لا يكتمل المشهد البانورامي الذي كنت تراه ناقصاً فحسب، بل تشعر باتساع مهيب، حيث يحتضنك هواء البحر وسماؤه على الفور، وهذا الاتساع قد لا تصادفه في حياتك إلا في غير هذا المكان.
الشعور بالاتساع وأنت أعلى قلعة قايتباي، تحتضن هواء البحر وسماؤه، أو هما سبقاك بالاحتضان، شعور له طعم مختلف، لأن الهواء هناك ممزوج برائحة التاريخ، وتداعبه أنفاس الماضي، وكأن ذلك الماضي لا يزال حياً.
ربما كان هذا الاتساع الجذاب أحد أسرار اختيار موقع المنارة المندثرة التي بنيت بين عامي 270 و282 ق.م، ثم انهارت إثر زلزال مدمر عام 1323م، وبعد ذلك شُيدت على أنقاضها قلعة قايتباي عام 1477م، لتؤديان دوراً مشتركاً في مراقبة شواطئ المدينة، الأولى كانت ترشد السفن بأمان للميناء، والثانية تحمي حدودها من الغزاة.
بعد أن تفيق من سَكرةِ احتضان هواء البحر وسمائه، تخطف عينيك وأذنيك سيمفونية موسيقية بديعة، يلحنها الصراع بين الماء برقته وأحجار القلعة بصلابتها، وكأنهما حبيبان يتشاجران ويتصالحان.
الصراع الخلاب بين الماء والحجر يصطحب الذاكرة إلى مشاهد متخيلة للمعارك العديدة التي شهدتها الإسكندرية قديماً، طمعاً في موقعها الجغرافي المتميز تارة، وطمعاً في كنوز الآثار الأسطورية الغارقة في مياهها المالحة تارة أخرى.
حين تشاهد وتستمع إلى تلك السيمفونية تتسلل إلى أنفاسك رائحة البحر ذات العبير الخالد، والتي تنفسها قبلك أعظم أباطرة التاريخ، ومنهم الإسكندر الأكبر الذي زحف بجيوشه ليفتح آسيا الصغرى ثم الشام، إلى أن وصل مصر عام 332 ق.م، حيث استقبله أهلها بالترحاب، نظراً للقسوة التي كانوا يعاملون بها تحت حكم الفرس.
مر الوقت سريعاً وأنا في قلعة قايتباي أتأمل سيمفونية التناغم والصراع بين الماء والحجر، ثم حان وقت العصاري، وصار الجو مهيئاً لأن أتلاحم أكثر مع تاريخ المنارة المندثرة، ومعرفة المزيد من المعلومات عنها، فلجأت إلى أحد الكتب التي اصطحبتها معي أثناء زيارتي للقلعة، وكان بينها عنوان «مدينة الإسكندرية» الصادر ضمن موسوعة وصف مصر، وهو للعالم الفرنسي جراتيان لوبير، وترجمه إلى العربية زهير الشايب.
يقول «لوبير» إن المنارة شيدت على صخرة تلاطمها مياه البحر من كل مكان، وكانت ترتفع عدة طوابق، ويحيط بكل طابق دهليز يدعمه صف من الأعمدة، وفي الليل يضيء برجها شعلتين يراهما القادم من على بُعد 300 غلوة (حوالي 55 كيلومتر طولي)، لترشد السفن في أعالي البحر إلى الدخول للميناء بأمان.
أما في النهار، فكانت هناك مرآة معدنية تنبه السفن للشاطئ قبل ظهوره في الأفق، وكانت المنارة أيضاً تستخدم بمثابة حصن، بينما أحجارها كانت من جرانيت أسوان والحجر الجيري من المكس والدخيلة، وزُينت بأعمدة ومسلات نقلت إليها من مدينة الشمس «هليوبوليس» بتكاليف باهظة.
متى وكيف نشأت الإسكندرية؟
وصلت في كتاب «وصف مصر» إلى نشأة وتاريخ الإسكندرية قبل أن يصل إليها مؤسسها الإسكندر المقدوني، فقد كانت تقع مكانها قديماً قرية على شواطئ البحر المتوسط تسمى «راكوتيس»، يقطنها الصيادون والرعاة، والذين كانوا يشغلون هذه النقطة من لسان ضيق تحيط به مياه المتوسط أو بحر الإغريق من الشمال، ومياه بحيرة ماريا من الجنوب.
وحسب «لوبير»، فإن المؤلفين العرب يرجعون إنشاء هذه القرية إلى مصراييم ابن حفيد النبي نوح، ويرجعه آخرون إلى الأمير شداد، وهو سابق على مجيء الإسكندر بزمن طويل.
ويشير «لوبير» إلى أن مصر كانت تئن منذ مائتي عام تحت سيطرة الفرس، وحينما جاء الإسكندر وأطاح بالكبرياء المستبد استقبلته مصر كمنقذ محرر، وفتحت ممفيس العاصمة أبوابها له بعد أن قدم القرابين إلى «أبيس»، ثم ركب النهر حتى كانوب «أبو قير حالياً»، والتف حول مريوط، وتوقف عند قرية «راكوتيس» التي أعجبه موقعها، فقرر الاستفادة من مميزاتها الطبيعية وتأسيس مدينة بها تكون عاصمة له.
أسطورة وخيال يمتزجان بالحقيقة
في الحقيقة، لم أجد الأسطورة والمغامرة التي أبحث عنها في قصة نشأة الإسكندرية بموسوعة «وصف مصر»، فطرقت أبواب كتاب آخر عنوانه: «مكتبة الإسكندرية القديمة سيرتها ومصيرها»، الصادر عام 1992 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وفيه يلقي الكاتب مصطفى العبادي الضوء على جزء من الحكاية الأسطورية لنشأة المدينة.
يقول «العبادي» في كتابه إن من بين جميع المدن العديدة التي أسسها الإسكندر في أرجاء إمبراطوريته الشاسعة، أثبتت الإسكندرية أنها أعظمها شأناً وأبقاها، وكما تختلط الحقيقة بالخيال والأسطورة عند تناول أي موضوع يتعلق بالإسكندر، كذلك لم تفتقر مدينته التي أسسها على ساحل مصر الشمالي لهذا العنصر الأسطوري.
وبحسب «العبادي»، فإن المؤرخين يروون أن الإسكندر عند اختياره الإسكندرية كي تكون عاصمة لإمبراطوريته، استهدى في ذلك بتوجيه معلمه الروحي هوميروس، والذي ظهر للإسكندر في الحلم، وأنشده أبياته المشهورة من ملحمة الأوديسة، عندما التجأ أبطال الملحمة إلى جزيرة فاروس، واستجابة لهذا الحلم غادر الإسكندر مخدعه في الحال، وذهب إلى فاروس، التي كانت آنذاك لا تزال جزيرة صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي للمصب الكانوبي.
تركت كتاب «العبادي» لأكمل طريق عودتي إلى منزلي عبر قطار الإسكندرية المتجه للقاهرة، وكان ذلك قبيل الغروب، على أن أعود لاحقاً إلى الجزء الخاص بجزيرة فاروس، في الرواية الأصلية بملحمة «الأوديسة».
في الطريق إلى القاهرة، انطبعت آثار أبطال حروب طروادة على وجوه جيراني في مقاعد الرحلة، وكلما ازدادت سرعة القطار ونظرت من النافذة، ترتسم في مخيلتي مشاهد لحلم «الإسكندر»، والذي ما لبث أن قرر تحويله إلى حقيقة، فبعدما ألقى الإسكندر نظرة على القرية المطلة على تلك الجزيرة، أدرك من فوره مزايا ذلك الموقع، فهو عبارة عن لسان من الأرض اليابسة، أشبه بالبرزخ، متناسق الأبعاد طولاً وعرضاً، وعلى أحد جانبيه تقع بحيرة كبيرة، وعلى الجانب الآخر البحر الذي شكل هناك ميناء طبيعياً، بما يجعل المنطقة تصلح أن تكون مركزاً حضارياً وثقافياً عالمياً.
«فاروس» في ملحمة هوميروس
حينما وصلت إلى منزلي، هرولت إلى ملحمة هوميروس «الأوديسة»، تصفحتها من البداية باغياً الوصول إلى حقيقة ذكر فاروس بها، وبالفعل وجدت أن «تليماك» ابن «أودسيوس» ملك إيثاكا ذهب إلى «مينيلاوس» ملك إسبرطة يسأله إن كان يعرف شيئاً عن مصير والده المختفي، صاحب فكرة الحصان الخشبي الذي اختبأ به المحاربون كي يتمكنوا من اقتحام طروادة.
حكى مينيلاوس عن أهوال الحرب وشجاعة ملك إيثاكا وجيشه المفقود، وأنه بعدما أضنى التعب جيوشهم، وضلت بهم الفلك، بلغوا شواطئ مصر عند جزيرة «فاروس»، وهناك كما يقول ملك إسبرطة : «ارتوينا من كوثر هذه البلاد التي تجري من تحتها الأنهار».
حتى حينما توقفت الريح لمدة 28 يوماً، كان المنقذ لـ«مينيلاوس» و«أودسيوس» عروس البحر «إيدوتيا» الجميلة، التي خرجت من مياه فاروس وحاولت مساعدة مينيلاوس ورفاقه، وألبستهم جلود عجول البحر، ليقابلوا والدها الكائن الأسطوري، الذي تحول من أسد غضنفر ذو لبدة، إلى أفعوان أرقم، ثم نمر ذي أنياب، ثم أيكة (شجر كثيف ملتف) ذات أغصان وأفنان.
ربما تخيل الإسكندر نفسه مكان أبطال «الأوديسة»، وأنه سيجد الملجأ في فاروس، فوقع في قلبه عشقها قبل أن يراها، ولهذا حينما وصل إليها استدعى على الفور مهندسه الإغريقي «دينوقراطيس»، وطلب منه إقامة مدينة يكون مركزها هذا المكان، فشيد المهندس جسراً يربط بين القرية والجزيرة، نتج عنه ميناءان، الشرقي والغربي، وقسّم المدينة إلى 5 أحياء، أهمها الحي الملكي «البروكيون»، والذي تزينت جميع أرضياته بالرخام واصطفت به التماثيل في كل جانب، وضم أيضاً جميع القصور الملكية ومراسي السفن والمعبد والمسرح والمكتبة والمقابر الملكية وغيرها، والتي تهدمت وغرقت بفعل الزلازل المتعاقبة التي شهدتها الإسكندرية، وبقي من أثرها بعض المعالم التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً.
بعد بضعة شهور، ترك الإسكندر مصر متجهاً نحو الشرق ليكمل باقي فتوحاته، ففتح بلاد فارس «إيران»، وتوج حاكماً لها، ولم يتوقف طموحه عند ذلك، بل واصل السير بجيشه إلى الهند وأواسط آسيا، ولكن القدر لم يمهله تحقيق باقي طموحاته، حيث داهمه المرض وتوفي وهو لم يتجاوز الـ33 من عمره، ونُقل جثمانه إلى مصر ليدفن في الإسكندرية، بناء على وصيته.
لغز مقبرة الإسكندر.. وأين مرقد رفاته؟
توقفت وأنا أطالع كتاب «العبادي» عند واقعة وفاة الإسكندر، وتذكرت مسلسل «حلم الجنوبي»، الذي أُنتج عام 1997 وأدى خلاله الفنان صلاح السعدني شخصية مدرس التاريخ نصر وهدان القط، ابن الصعيد العاشق للحضارة المصرية القديمة، والذي وقعت تحت يديه بالصدفة بردية قديمة تكشف لغز مقبرة الإسكندر الأكبر، ويجد ذلك المدرس الكثير من المشقة خلال معترك البحث عن المكان الذي ربضت فيه رفات الإمبراطور الراحل بعيداً عن أعين العالم، طوال أكثر من 231 قرناً من الزمان.

وعلى الرغم من أن المؤلف والسيناريست الراحل محمد صفاء عامر حاول رسم المشقة التي تكبدها مدرس التاريخ في أحداث المسلسل ببراعة، لكن وقائع المحاولات الكثيرة للبحث عن المقبرة ربما تكون أقسى من تلك المشقة بكثير.
كانت آخر محاولات البحث عن قبر الإسكندر بالمصادفة في يوليو 2018، حينما انشغل العالم بالحديث عن تابوت أسود اللون، وجده أحدهم أثناء حفر أساس بناء جديد بمحافظة الإسكندرية، واعتقد البعض أن هذا التابوت الأسود يضم رفات الإسكندر الأكبر، لكن ما لاح من حلم العثور على المقبرة تبخر مع إعلان رسمي بأن التابوت لا يضم سوى بعض الرفات البالية، وأنه لا يخص باني الإسكندرية، أو حتى أياً من الملوك والأباطرة الآخرين.
في العصر الحديث، ناهز عدد أعمال البحث عن مقبرة القائد المقدوني نحو 150 محاولة، باءت جميعها بالفشل، ولا تزال المقبرة تشكل لغزاً يحير كل عشَّاق التاريخ.
ويعتقد بعض علماء الآثار أن مقر المقبرة يقع عند تقاطع الجادتين الرئيسيتين اللتين كانتا تربطان الشمال والجنوب بالشرق في المدينة القديمة، والذي يقع الآن في تقاطع شارع النبي دانيال مع طريق الحرية في قلب الإسكندرية، لكن يبدو أن سر المقبرة ومرقد رفات صاحب الإسكندرية قد يبقى لغزاً إلى الأبد.
معبد الثقافة القديمة والحديثة
مثلما شكلت منارة الإسكندرية الأعجوبية وقلعة قايتباي، ثنائية بديعة، تزخر مزائن الإسكندرية أيضاً بثنائية أخرى وهي مكتبة الإسكندرية المندثرة والمكتبة الجديدة، ففي سنة 295 ق.م، شُيدت مكتبة الإسكندرية القديمة خلال عهد بطليموس الثاني، وفي عام 2002 م حاولت مصر إحياء ذكراها وروحها بإنشاء مكتبة الإسكندرية الجديدة.
يقول «العبادي» في كتابه عن مكتبة الإسكندرية المندثرة، إنها كانت وتوأمها العلمي «الموسيون»، تجربة هامة في تاريخ الثقافة العالمي، ورغم احتراق مكتبة الإسكندرية، لكن إنجازاتها العلمية والفكرية ظلت خالدة إلى يومنا هذا، قنديلاً للعلماء في العصور الوسطى من المسلمين والمسيحيين على السواء، ونبراساً لعصر النهضة الأوروبية وما بعده.
كانت المكتبة بمثابة أول معهد أبحاث حقيقي في التاريخ، ومن أبرز علمائها «إقليدس» الذي تتلمذ على يديه أعظم الرياضيين مثل أرشميدس وأبولونيوس، وهيروفيلوس عالم الطب والتشريح، وجالينوس في الصيدلة، وإريستاكوس في الفلك، وثيوكريتوس في الشعر والأدب.. وعشرات غيرهم ممن غيروا شكل العالم بأفكارهم ونظرياتهم الخالدة.
ضمت المكتبة المندثرة بين طياتها أغلب المخطوطات الأدبية والفلسفية والعلمية، واستعيرت لها مخطوطات سوفوكليس وأوريبيديس من أثينا، وكانت تحتوي على تاريخ بابل، وكتب المعتقدات الفارسية، والمؤلفات البوذية، حتى وصل عدد الكتب الموجودة فيها إلى ما يربو عن 700 ألف مجلد، بما في ذلك أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو.
وفي محاولة لإعادة أنفاس الحياة للمكتبة القديمة، شَيدت مصر مكتبة الإسكندرية الجديدة، وافتُتحت في احتفالية ضخمة عام 2002 لتكون أول مكتبة رقمية في القرن الواحد والعشرين، وتضم بين جنباتها ملايين الكتب باللغات المختلفة، إضافة إلى 3 متاحف للآثار والمخطوطات وتاريخ العلوم، و7 مراكز بحثية متخصصة، وتستقبل ما يقرب مليون زائر سنوياً.
من الثقافة إلى الحب
كان حريق مكتبة الإسكندرية في عصر الملكة الشهيرة كليوباترا، آخر ملكات البطالمة في مصر، وبعيداً عن الأعمال الروائية والفنية العديدة التي تناولت قصتها، التجأت إلى الدكتور علاء عبدالمحسن شاهين، أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم، وعميد كلية الآثار الأسبق جامعة القاهرة، لتوثيق بعض المعلومات عنها وعن تاريخ الإسكندرية القديمة، فقال لي إن شهرة كليوباترا تنبع من كونها سحرت اثنين من أعظم وأشهر أباطرة روما، أولهما كان يوليوس قيصر، والثاني مارك أنطونيو، وشكلت مع الأخير واحدة من أشهر ثنائيات الحب في التاريخ.
وبحسب الدكتور علاء شاهين، فإن كليوباترا قد اختطفت قلب القائد الروماني الشهير يوليوس قيصر، بعد أن أدهشته بذكائها وجمالها الفاتن، وبعد اغتياله عام 44 ق.م، كان الجزء الشرقي للإمبراطورية الرومانية من نصيب «مارك أنطونيو» الذي أرسل إلى كليوباترا طالباً لقاءها، فلم تتأخر عنه، وفي الوقت ذاته كانت «سهام كيوبيد» تنتظر هذا اللقاء لتخترق قلب الاثنين، فيقع أنطونيو في حب الملكة الفاتنة ويتزوجها وينجب منها 3 أبناء، على الرغم من أن القانون الروماني لم يكن يسمح بالزواج من أجنبيات.
وقد خلد الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، معالم قصة العشق الخالدة بين أنطونيو وكليوباترا، في إحدى رواياته الشهيرة، والتي استوقفني فيها حواراً بين العاشقين يلخص طعم العشق ومداه إن كان له مدى:
• كليوباترا: إذا كان ما بك حقاً هو الحب، فقل لي كم تحبني؟
• أنطونيو: ما أفقر الحب الذي يقاس ويحصى.
• كليوباترا: دعني أرسم الحدود لحبي.
• أنطونيو: إذن فابحثي عن سماء وراء هذه السماء، وعن أرض غير هذه الأرض.
الآثار الغارقة.. شواهد أسطورية في أعماق البحر
كان ما سابق جزء بسيط جداً من تاريخ الإسكندرية القديمة، ولكن بقي سؤال مهم: أين شواهد ذلك التاريخ الحافل؟
.. للإجابة عن هذا السؤال كان لا بد الارتكان إلى أحد الخبراء في علم الآثار المصرية القديمة، وبعد البحث توصلت لدراسة أجراها الدكتور محمد مصطفى عبدالمجيد، كبير باحثين بوزارة الآثار المصرية ونائب رئيس اللجنة المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، فالتجأت إليه مباشرة وطلبت منه المساعدة في إمدادي بخارطة الاكتشافات الأثرية للإسكندرية القديمة.
بدأ الدكتور «عبدالمجيد» حديثه معي بسرد تاريخ محاولات البحث عن الآثار الغارقة في مصر، منذ بداية القرن العشرين، حين لعبت الصدفة دورها في العثور على رصيف بحري قديم بخليج الدخيلة في الإسكندرية عام 1908م، حيث شكا منفذو عملية إنشاء رصيف بحري جديد، من وجود صخور تُعيق تنفيذ المشروع، ثم تبين أنها بقايا رصيف قديم مكون من كتل كبيرة الحجم مصفوفة بعناية، وبدون مادة لصق فيما بينها.
ويوضح أنه كان من الغريب أن بقايا رصيف الميناء القديم لم تكن تبعد عن مشروع الميناء الجديد بأكثر من 20 مترا، كما أنه يأخذ نفس الاتجاه لحماية السفن من الرياح الشمالية والشمالية الغربية التي تهب على ساحل مصر الشمالي، ويعتقد العلماء أنه أقيم لنفس الغرض، وهو جلب الأحجار إلى الإسكندرية من محاجر المكس مثلما كان الهدف من الميناء الجديد، وربما يؤكد هذه النظرية العثور على بقايا حطام سفينة شمال قلعة قايتباي تحمل كتلاً ضخمة من الحجر الجيري.
وتحدث الدكتور «عبدالمجيد»، عن شخصية كان لها الفضل في وضع مناطق قايتباي والميناء الشرقي وشرق السلسلة وخليج المعمورة في قمة قائمة المناطق الأثرية الغارقة، وما يقوم به الأثريون منذ سنوات وحتى الآن، ليس إلا إعادة اكتشاف لما أشارت إليه تلك الشخصية، ولكن بشكل علمي.
هذه الشخصية، هي الراحل كامل أبو السعادات (1934-1984م)، والذي كان يعمل بشركة مستودعات، وفي ذات الوقت كان هاوياً للغوص وصياداً بالحربة، وقد أعاد الآثار الغارقة إلى بؤرة الاهتمام في بداية الستينيات، وكان يتمتع بثقة الجهات العسكرية التي منحته تصاريح الغوص في سواحل الإسكندرية، في الوقت الذي كانت هذه السواحل مناطق عسكرية مغلقة.
ويشير «عبدالمجيد» إلى أن «أبو السعادات» نموذجاً قل أن يتكرر مثله، فنحن لا نجد صياداً واحداً يستطيع أن يدلنا على بقايا أو أطلال غارقة على كثرة عددهم، في حين أن هذا الرجل قدم لنا خريطتين محدد على إحداهما الآثار الغارقة عند سفح قلعة قايتباي والميناء الشرقي، أما الخريطة الثانية فحدد عليها مواقع سفن أسطول نابليون بونابرت الغارقة، وضاحيتي مدينة «كانوب» القديمة، المعروفتين اليوم باسم «هرقليون ومينوتيس»، وكذلك الأطلال المحيطة بجزيرة «نيلسون» بخليج أبي قير.
لم يكتف «أبو السعادات» بهذا، بل أضاف لخرائطه الأعماق المختلفة وهوامش بمشاهداته، وقد تمكن من إقناع مصلحة الآثار في ذلك الوقت بانتشال تمثال لرجل بالحجم الطبيعي من الجرانيت الأحمر مكسور الرأس والقدمين، يرجع للعصر الهلنستي، وذلك في يونيو عام 1962 بمساعدة القوات البحرية.
وفي نوفمبر من نفس العام، تعاون «أبو السعادات» مع القوات البحرية مرة أخرى في انتشال تمثال ضخم من الجرانيت الوردي من المياه، بجوار قلعة قايتباي، يعتقد أنه تمثال «آرسينوي الثانية»، زوجة بطليموس الثاني.
ويوضح الدكتور «عبدالمجيد»، أن المهندس الفرنسى جاستون جونديه قدم بين عامي 1910 1916، خريطة للمنشآت الغارقة على مشارف جزيرة فاروس، وبعد انتشال تمثال «آرسينوري» عاد الاهتمام بالموقع مرة أخرى، وفي عام 1975 نُشرت نتائج أعمال خبيرة الآثار البحرية أونو فروست، والجيلوجي فلاديمير نستروف، والذين وضعا بمساعدة «أبو السعادات» خريطة دقيقة للآثار الغارقة في هذا المكان، وفي عام 1979 حضر مجموعة من الأمريكيين قاموا بالغوص في الموقع بحثاً عن قبر الإسكندر، وفي العام التالي قامت مجموعة إيطالية بتصوير فيلم تسجيلي عن الموقع الأثري بجوار القلعة وكذلك عن مواقع حطام السفن الغارقة إلى الشمال منه.
ويتابع أن مركز الدراسات السكندرية (CEA) بدء عام 1994 بعمل حفائر إنقاذ في الموقع الذي يحتوي على أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية معمارية (أساطين، قواعد، تيجان، أعتاب)، تنتمي للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وفي حين عُثر على نقش واحد باللغة اليونانية، عُثر في المقابل على مجموعة كبيرة من النقوش الهيروغليفية.
وفي أكتوبر عام 1995 تم اختيار عدد 34 قطعة لانتشالها، كما تم انتشال كتلتين إضافيتين أمام رئيس جمهورية فرنسا في أبريل 1996، وروعي في اختيار هذه القطع أن تكون نموذجاً لكل ما هو موجود تحت الماء من الناحية الأثرية والفنية والتاريخية، وبينها بعض الكتل من مكان منارة الإسكندرية المندثرة.
الميناء الشرقي و «أبو قير».. عالم آخر تحت الماء
انتقل الدكتور «عبدالمجيد» إلى موقع آخر لشواهد التاريخ السكندري القديم، وهو منطقة الميناء الشرقي، وقد بدأت بعثة المعهد الأوروبي لعلم الآثار تحت الماء «IEASM» نشاطها بعمل مسح أثري تحت الماء عام 1996، وأسفرت هذه الأعمال عن خريطة طبوغرافية للنصف الشرقي من الميناء، ومع استمرار العمل تم العثور على مجموعة كبيرة من أبدان الأعمدة الجرانيتية، كما أمكن تحديد شكل الميناء الشرقي والموانئ الملكية بداخله، وخط الساحل القديم، والصخور الغارقة والجسور الصناعية التي شيدها البطالمة، وكذلك أطلال المباني القديمة، وآثار قديمة تقدر بحوالي 1600 قطعة، مختلفة الأحجام والأحجار، منها تماثيل لـ«أبو الهول» أحدها على شكل لبطليموس الثاني عشر، ورأس ملكية من الجرانيت للإمبراطور أغسطس، ومجموعة أخرى من التماثيل تنتمي للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.
وبالنسبة لخليج «أبو قير»، يشير الدكتور «عبدالمجيد» إلى أن هذا الموقع يتميز باحتوائه على التراث الغارق منذ العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة، وتتمثل المواقع القديمة في مدينة كانوب ومعابدها القديمة، ومن أهم تلك المعابد «هرقليون» و«أوزيريس- سيرابيس».
ويوضح خبير الآثار أنه في عام 1933م لاحظ طيار من السلاح الملكي البريطاني، وجود مباني غارقة في خليج «أبو قير» على شكل حدوة حصان، وعندما علم الأمير عمر طوسون (ابن محمد سعيد باشا - والي مصر آنذاك)، اهتم بالأمر وبدأ بالبحث والتحري، وأبلغه صيادو قرية «أبو قير» عن مكان معين في قاع الخليج يوجد به آثار ومبنى مهدم.
قاد «طوسون» أول محاولة للغوص في خليج «أبو قير»، وتوصل إلى العديد من الآثار بينها معبد على مسافة 240 متر من الساحل، وحاجز أمواج قديم يمتد مسافة ما بين 100 إلى 250 متر، وأخرج الغواصون في مايو 1933 رأس تمثال من الرخام الأبيض للإسكندر الأكبر، وأمكنهم تحديد موقع ضاحية «هرقليون» على الخريطة.
وفي الضاحية الأخرى وهي «مينوتيس»، فقد بدأ المعهد الأوروبي منذ عام 1999م العمل على المواقع القديمة، واضعاً في الاعتبار أهمية الكشوف التي قام بها «طوسون» وفريقه، وكشف عن مجموعة غاية في الأهمية من الآثار الثابتة والمنقولة منها معبد «إيزيس» ومجموعة كبيرة من التماثيل يرجع أقدمها لعصر الأسرة الـ 25 وأحدثها لنهاية العصر الروماني، وكذلك عثر على حلى رومانية وبيزنطية وعملات بيزنطية وإسلامية بينها دينارات تعود لعامي 79 و100 هجرية، فضلاً عن بقايا لحيوانات مستأنسة ومفترسة، كما عثر على تربة طينية أسفل الرمال بعمق 5 أمتار وعليها طبعات لحوافر الأبقار، كما اتضح من الجسات أن المدينة كانت في أوج نشاطها في العصر الروماني، واستمرت قليلاً إلى العصر الإسلامي، ثم غمرتها المياه.
أما الآثار الحديثة، فيشير الدكتور «عبدالمجيد» إلى أنها تمثلت في أسطول القائد الفرنسي نابليون بونابرت، والذي حطمه عدوه الإنجليزي بقيادة نيلسون في أول أغسطس عام 1798م، وغرقت 6 سفن من الأسطول الفرنسي ومعها سفينة القيادة أورينت، واستقرت جميعها في قاع الخليج فيما عرف بمعركة أبي قير البحرية، وفي عامي 1965 و1966م استطاع «أبو السعادات» أن يحدد سبعة مواقع لسفن الأسطول قرب جزيرة نيلسون، ثم عمل لاحقا مع البعثة الفرنسية «بونابرت» عام 1983م والتي عثرت على سفينة أورينت، ومجموعة من مدافعها، وقد تم التعرف عليها بعد العثور على اسمها القديم «الدرفيل الملكي» على دفتها التي تزن نحو 14 طنا وطولها نحو 9 أمتار، كما عملت بعثة المعهد الأوروبي على حطام الأسطول مرة أخرى في عام 1998 وعثرت على آثار أخرى مشابهة.
«هرقليون» .. ذاكرة البشرية


وثَّق «جوديو» أبرز اكتشافات بعثته في «هرقليون»، والتي تقع على بعد 7 كيلومترات من شاطئ «أبو قير»، وتحتضن الكثير من الحكايات والشواهد الخالدة، منها آثار ضخمة تنتمي للحقب الفرعونية والإغريقية والبطلمية.
 ويشير جوديو في مقال على موقع الإلكتروني، إلى أن البعثة استطاعت انتشال العديد من الآثار الفريدة بينها تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر لفرعون يبلغ ارتفاعه أكثر من 5 أمتار ووزنه 5.5 أطنان، وبقايا معبد هرقليون، وتمثال مظلم رجح أنه من المحتمل جداً أن يكون للملكة البطلمية كليوباترا، وتماثيل لـ«أبو الهول» و«إيزيس» والعديد من الآثار الأخرى.
ويشير جوديو في مقال على موقع الإلكتروني، إلى أن البعثة استطاعت انتشال العديد من الآثار الفريدة بينها تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر لفرعون يبلغ ارتفاعه أكثر من 5 أمتار ووزنه 5.5 أطنان، وبقايا معبد هرقليون، وتمثال مظلم رجح أنه من المحتمل جداً أن يكون للملكة البطلمية كليوباترا، وتماثيل لـ«أبو الهول» و«إيزيس» والعديد من الآثار الأخرى.ويؤكد العالم الفرنسي أن اسم المدينة محفور في ذاكرة البشرية والنصوص الكلاسيكية القديمة والنقوش النادرة، وقد كانت تسمى أيضا باسم «ثونس - Thonis»، وكتب عنها المؤرخ اليوناني هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد عند الحديث عن حرب طروادة، وقد تأسست المدينة على الأرجح خلال القرن الثامن قبل الميلاد، وخضعت للكوارث الطبيعية المختلفة، حتى غرقت في أعماق البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الثامن الميلادي.
كنوز النبش في التاريخ
لقد مات الإسكندر وبعده بطليموس الأول والثاني ثم أنطونيو وكليوباترا، وغيرهما العشرات بل والمئات من رموز الإسكندرية القديمة، لكنهم تركوا لنا ثلاثية خالدة من المعالم الأثرية والقصص العظيمة التي لا زالت مصدر إلهام لنا حتى اليوم، وكان ما سبق محاولة بسيطة لإلقاء الضوء على ذكرى مدينة امتزج تاريخها بين الأسطورة والواقع، وتذخر رمالها ومياهها وهواءها بشواهد التاريخ ومذاقه ورائحته في كل مكان.
غير أن النبش في تاريخ الإسكندرية لم يكن هيناً، خاصة مع ندرة المحتوى العربي على الإنترنت فيما يتعلق بالتاريخ العظيم لأمتنا، وحتى ما يتوافر من معلومات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية فالكثير منه إما مجتزأ ومنسوخ من بعضه، أو غير موثق، ولهذا كانت تلك المحاولة لمزج جولتي الصحفية في مكان منارتها الأعجوبية المندثرة، وأبرز ما كتب عن الإسكندرية في المصادر التاريخية، فضلاً عن آراء الخبراء والأكاديميين، والصور الموثقة، والخريطة التفاعلية اللاحقة التي حاولت أن أضع بها الأماكن التقريبية لأبرز الآثار المندثرة والحيّة، آملا أن يكون هذا النبش بمثابة صرخة إيجابية ودعوة إلى الباحثين لتوثيق تاريخنا وتقديمه للعالم بكل اللغات، ودعوة للجهات المسؤولة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «اليونسكو» ومختلف المؤسسات الثقافية، للتنقيب في الإسكندرية عن باقي تاريخها وآثارها القديمة.
آنت الخاتمة الآن، لكن لم يأت بعد أوان اندثار ذكرى الإسكندرية القديمة، أو أن يظل البعض يختصرها في الرحلات الممتعة والتنزه في شواطئها ومحالها الجميلة صيفاً وشتاءً.. إسكندرية الحالية جميلة بالفعل، لكن الإسكندرية القديمة ستجدونها جميلة أيضاً، وتستحق أن تستمتعوا بها، والخلاصة يمكننا القول: «اذهبوا إلى الإسكندرية واكتشفوا رونقها، فالجمال يسكن هناك، والتاريخ أيضاً يسكن هناك».