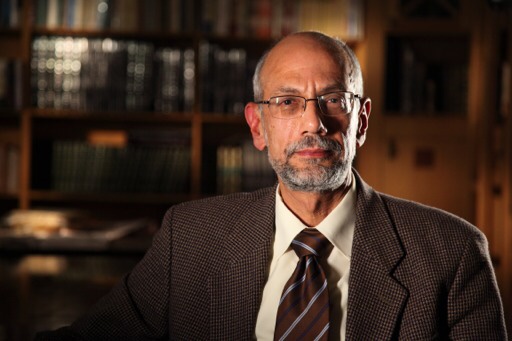هل بتنا اليوم، بعد سنوات خمس فى حاجة لإعادة التذكير والقراءة .. والتدبر؟أترك الإجابة لكم.
الدولةُ التى تتحسب لاقتراب ذكرى يوم ثورة يصفها دستورها بأنها «فريدةٌ بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية»، ربما كان عليها، بدلا من أن تحرك مدرعاتها إلى الشوارع أن تسأل السؤال البسيط: إلى أى مدى تحقق ما طالب به الناس عندما «ثاروا» قبل خمسة أعوام كاملة؟
فى ألبوم الصور المزدحم، الذى حاولوا محوه من الذاكرة، تبقى صورة Dylan Martinez مصور رويترز للشعار الذي صار عنوانا للتظاهرات يومها «الشعب يريد إسقاط النظام» كافية لأن نقرأ فى ألوانها وظلالها، ليس فقط لماذا جرى ما جرى يومها، بل وأيضا لماذا مازلنا هنا رغم أعوام خمسة، وعهود حكم أربعة.
هل تذكرون؟ كان اليوم هو الحادي عشر من فبراير ٢٠١١، الثامن عشر من أيام ثورة تميزت فى ملامحها وصورها وتفاصيلها الصغيرة. وكان الشعار الذى أصبح تجسيدا و«تلخيصا» لكل الشعارات والمطالب، قد أخذ مكانه مبكرا «وواضحا» فى صدارة المشهد أصواتا تهتف، ولافتات تحسم: «الشعب يريد إسقاط النظام».
أيامها لم يكن أحدٌ يعرف إلى أين ستصير الأمور بين عناد قصر لا يريد أن يصدق، وصمود شارع لا يمكنه أن يتراجع.
كانت الأجواء على كل صعيد متوترة. كان الكثيرون ــ هنا وهناك ــ لا يعرفون أين يضعون أقدامهم، إن فى وسائل إعلام تخبطت رسائلها، أو فى عواصم العالم التى لم تكن تعرف ــ أو تصدق ــ إلى أين تسير الأمور، فترددت، وتباطأت.. وتأخرت.
وحدهم الملايين الذين كانوا فى الميدان كتلة «واحدة» من البشر؛ بطوائفها وتياراتها وألوانها تحت علم واحد، كانوا يعرفون طريقهم، أو على الأقل كانوا يعرفون ما يطلبون: «الشعب يريد إسقاط النظام».
قبل أن ينتهى اليوم الحادى عشر من فبراير الذى تباينت الحكايا فى تفاصيله، ذهب مبارك، بغض النظر عن التباينات فى توصيف هذا الذهاب؛ خروجا أم إخراجا، توافقا أم اتفاقا.. إجبارا أم امتثالا للبديل الذى لا بديل له. لم يكن هذا وقت التفاصيل على أية حال. فـ«الصندوق الأسود» مازال فى أعماق بحر التاريخ العميق. وربما «ليس كل ما يعرف يقال.. أو ليس كل مايقال جاء أوانه..» إلى آخر حكمة الإمام على ــ رضى الله عنه.
أيا ماكان الأمر، وأيا ما كانت التفاصيل، فالرجل «ذهب» مساء ذلك اليوم الذى ردد فيه الملايين؛ مسلمين ومسيحيين «دعاء القنوت» خلف شيخ ــ رغم شهرته ــ لم يتخيل يوما أنه سيقف من الله والناس هذا الموقف.
خرج الرجل إذن غير مصدق «وإن انفلق البحر..» لتحل الأهازيج ليلتها محل الهتافات، والأغاني محل الشعارات.. ومن بينها بالضرورة شعار المطلب الأهم؛ الجامع لكل المطالب والشعارات: «الشعب يريد اسقاط النظام». وكان طبيعيا ومنطقيا أن يصبح سؤال اليوم التالى: إن كان مبارك قد سقط، فهل سقط النظام؟
«الشعب يريد إسقاط النظام»؛ عبارة من أربع كلمات لا أكثر، جامعة مانعة كما يقول المناطقة. لخص بها الشعب مطلبه يومها متجاوزا ما ظنه البعض مجرد الإطاحة بالرئيس، أو ما تمناه البعض مجرد إقصاء للوريث «القادم من خارج المؤسسة».
النظامُ الذى طالب الناس وقتها باسقاطه، ليس نظام الحكم أو «الدولة»، كما يحلو للبعض أن يقول، بل منظومة العلاقات والقيم الحاكمة والمسؤولة عن تعثر مجتمع ودولةٍ أراد الجيلُ الجديد من أبنائها أن يضعها على الطريق إلى عصرٍ جديد، ومستقبلٍ تستحقه.
النظامُ الذى طالب الناس يومها بإسقاطه، بحثا عن «الدولة المعاصرة» هو ذلك النظام الذى لا يدرك أن «السلطة المطلقة، مفسدة مطلقة». مهما تزينت تلك السلطة «المطلقة» بشعارات دينية أو وطنية. ومهما زين لها المنافقون أن المصلحة الوطنية تقتضى أن تصبح «القوة فوق العدل».
وهو النظام الذى كان بعض ما وصفناه به يومها أنه ذلك الذى يصبح فيه الخوف، ومن ثم «نفاق السلطة» أيا ما كانت هذه السلطة؛ الأداة الوحيدة للحفاظ على المكان.. أو للفوز بالمكانة. يتساوى فى ذلك وزراءٌ وخفراء، ورجال دين وسياسة وفكر.. ليبدو الأمر كله فى نهاية المطاف «ثقافة شعب» أو بالأحرى «ثقافة مرحلة».
نظامٌ لا يعنيه أن يكون استقلال القضاء استقلالا حقيقيا، يشعر به الناس ميزانا لا يهتز وعدالة عمياء. نظامٌ لم يكترث القائمون عليه يوما لخطورة أن يتعمق لدى المواطن شعورٌ باليأس من اللجوء إلى التقاضي «سبيلا سلميا لحل المنازعات». غير مدركين أن فقدان الثقة فى القضاء، إذا حدث يصبح الأمن الاجتماعي مهدَدا. كما يصبح مفهوم الدولة ذاته فى خطر.
هو النظام الذى كان يعصفُ بالقانون، فأصبح يتعسف فى استخدام ما تسمح به نصوص القانون.
هو النظام الذى كان قمعيًا، فأصبح يقنن القمعَ وينجح فى أن يصفق له المقموعون.
النظامُ الذى طالب الناس يومها بإسقاطه، بحثا عن «دولة الدستور والقانون»، هو ذلك النظام الذى يقوم على «التحريات الأمنية» التى قد تخطئ أو تصيب. وتتحكم فيه تقارير الأمن فى كل شىء، من تعيين السعاة فى المكاتب، وحتى اختيار العاملين فى معامل الجامعات. هو النظام الذى كان يسمح بأن يحدث مثل ما حدث مع خالد سعيد وسيد بلال، ثم بات يسمح بأن يحدث ذلك مع كثيرين مثلهما بتنا لا نعرفهم من كثرة الأسماء.
النظام الذى لا يعرف خطورة أن يكون هناك آلاف من المظلومين، وأن «دائرة الثأر» لا تنتهي.
نظام لا يدرك خطورة أن تجعل ظهر هذا أو ذاك إلى الحائط، أو ماذا يمكن أن تقود إليه إجراءات أمنية ظالمة أو عقيمة بشاب أضاعت مستقبله. نظام لا يدرك نتيجة ذلك كله على أمن الوطن والمجتمع.
النظام الذى يدفع من يستطيع من الشباب إلى النظر خارج الحدود. ويدفع كثيرين ممن كانوا قد عادوا إلى مصر بعد يناير إلى إعادة النظر فى قرارهم.
النظام الذى يقوم على شبكة مصالح مترابطة بين السلطة والمال وأصحاب القدرة على البطش الأمني، ويقوم على «توريث» فج للمناصب والنفوذ. وشراء حقيقي للذمم والضمائر.. والأرض.
النظام الذى لا يدرك أن «الشفافية» هى النقيض الموضوعي «للفساد»، فيدعي أنه يحارب الفساد بإجراءات تئد الشفافية. وتُعتم على البيانات والمعلومات ذات الصلة.
نظامٌ لا يكون فيه «المواطنون أمام الدولة والقانون سواء» رغم أنف الدستور، فيحرم شابا من وظيفة «يستحقها» لأن تقارير «أمنية» أشارت إلى أنه سلفي أو شيوعي أو شيعي أو بهائي أو منتم للإخوان المسلمين. كما يحرم آخر، رغم تفوقه من «الوظيفة المرموقة» لا لسبب إلا أنه «مسيحي» أو ينتمي إلى طبقة اجتماعية «مكافحة»، كما يحكى لنا المؤرخ الكبير رؤوف عباس فى مذكراته الصريحة الصادمة.
النظام الذى يضطر فيه الناس إلى تجنب كثير من الحديث الهاتفي، حتى الشخصي مع عائلاتهم خشية أن يسمعها أو يقرأها العامة غدا «مستلة من سياقها» على هذه القناة أو تلك الصحيفة.
النظام الذى لا يحب ثقافة التفكير النقدي Critical Thinking، والذى قد يعلم الناس المعارضة، فتشيع فيه بدلا من ذلك ثقافة السمع والطاعة والتلقين والاتباع؛ تُربةً خصبة لثقافة مريضة تدفع هذا أو ذاك إلى أن يظن أن طريق الجنة يمر بتفجير يستهدف أبرياء.
النظام الذى يسمح بثقافة ديماجوجية شوفينية، تروج أن «مصر فوق الجميع»، ثم لا تتردد أبواقه في أن تتهم عصام حجي «بالعمالة» لمجرد أنه تجرأ فذكر ملحوظات علمية على ما جرى ترويجه على أنه «ابتكار علمي».
النظام الذى يضيق صدره بسؤال «مهذب» من الراحل النبيل محمد السيد سعيد (معرض الكتاب ٢٠٠٥)، ثم بانتقاد «على استحياء» من هذا الإعلامى أو ذاك (٢٠١٥).
النظام الذى لا يدرك أن الصمت وإن أراحه، فهو يترك أمراض السلطة الأوليجاركية «ثلاثية المفعول» تسري فى هدوء مميت، فلا يفيق إلا وقد انهارت أساساته، فيسقط على من فيه؛ دولة فاشلة لا مكان لها فى العصر الحديث.
هو النظام الذى بناه بدأب «كهنة الفرعون»، يعدلون الدستور عام ١٩٨٠، ليسمح بتأبيد الحكم فى شخص الرئيس (السادات وقتها)، ثم ــ لاعتبارات المظهر «الخارجى» ــ يجرون له جراحة تجميلية (فى ٢٠٠٥، ثم ٢٠٠٧) لا تخف رغم المساحيق حقيقة أنها «حيكت» بمهارة تضمن أن «يظل الرئيسُ رئيسا».
النظام الذى طالب الناس يومها بإسقاطه، هو ذلك الذى كان رئيس الدولة لثلاثين عاما كاملة يخرج فيه فى كل مناسبة ليتساءل: «من أين يطعم شعبه»، ثم يفاجأ أولئك الجياع بأنه كان يعوم على بحر من الفساد والمليارات المنهوبة.
النظام الذى لا يسمح فقط بما قرأناه فى حيثيات حكم (أصبح باتا) فى قضية القصور الرئاسية، بل يطيح بمثل وقيم ومستقبل ضابط مهندس شاب، بعد أن يدفعه دفعا فى طريق ربما لم يكن ليخطو فيه خطوة واحدة لولا ثقافة إفساد سادت، لتجعل من الفساد اعتيادا يألفه الناس ويعايشونه فلا يأنفه هذا أو ذاك. (لمزيد من التفصيل يرجى العودة مرة أخرى إلى ما كتبه حسام بهجت فى موقع «مدى مصر» بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٤).
من سطور حيثيات الحكم فى قضية قصور الرئاسة، وبغض النظر عن الأسماء والتفاصيل: «أنه وقت الواقعة كان رئيسا للجمهورية.. واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه فى نفوس مرءوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم الأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرءوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال.. إلخ»
تتحدث العبارات هنا عن «سلطان السلطة، ورهبة المرءوسين»، وهى ثنائية لا تدانيها فى تعبيد الطريق نحو الفساد والدولة الفاشلة، غير الثنائية «المطلقة» للسمع والطاعة.
أرجوكم للمرة الألف أن تقرأوا تفاصيل القضية التي صدر فيها الحكم باتا قبل أسابيع بإدانة مبارك ونجليه، ففي سطورها بعض الإجابة على سؤال: «لماذا ثار الناس؟» كم أن في قراءتها، فضلا عن قراءة «ما صرنا إليه من حال» تذكير بملامح «النظام» الذي ثار عليه الناس.
«السلطة المطلقة.. مفسدة مطلقة» هكذا تعلمنا، وكان أن قرأنا فى كتب السياسة وتجارب السابقين أن الفساد لا عدو له غير الشفافية، وأنه لا يترعرع إلا فى ظلام دولة أمنية قمعية، تروج فيها ثقافة أن «السلامة فى الصمت»، وتلجأ فيها السلطة إلى أن «تضرب المربوط.. فتخاف السائبة» كما يقول المصريون فى أمثالهم.
النظام الذى طالب الناس يومها باسقاطه، هو ذلك الذى نبهنا يومها (وجهات نظر: فبراير ٢٠١١) إلى أن «أصابعه تلعب في الميدان» ، وإلى أنه حتمًا سيكون أول المستفيدين من حمق معاركنا الصغيرة .. ليعود.
•••
وبعد..
فالصورة قديمة.. كما أن كثيرا مما سبق ليس أكثر من سطور من مقال «قديم» كنت قد نشرته فى «وجهات نظر» عشية الحادى عشر من فبراير الشهير (قبل سنوات خمس) وسط أهازيج واحتفالات رأيتها مبكرة.. وربما «ساذجة». معتبرا أن جهد صاحب الرأى فى مرحلة هى بتعريف العلوم السياسية مازالت «انتقالية» هو ألا يمل التذكير بتفاصيل «رئيسة» قد تغيب وسط الصخب. وأن أهم هذه التفاصيل هو تحديد ملامح «النظام» الذى ثار الناس عليه.
يومها (فبراير ٢٠١١) قلت أن هذه هى ملامح «النظام» الذى إن لم ننتبه، فلست متأكدا أنه «متسللا» لن يعود. ويومها ذكرت بما تعلمته من أهل قريتى من أنه «لا يكفى أبدا أن تقطع رأس الحية..».
هل بتنا اليوم، بعد سنوات خمس فى حاجة لإعادة التذكير والقراءة .. والتدبر؟
أترك الإجابة لكم.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة