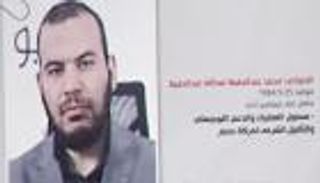عودة «مباراة إخوان الأردن».. كيف تحاول الجماعة إحراز أهدافها بالتسلل؟

بمجرد أن دوّى قرار حظر جماعة الإخوان بالأردن، لم يكن السؤال: هل انتهت؟ بل: من أين ستخرج هذه المرة؟ السؤال كان جاهزًا، والإجابة أكثر جهوزية، فها هي "جمعية الإخوان" تعلن حلّ نفسها طوعا، وكأن التاريخ لا يعيد نفسه فقط، بل يواصل عرض المسرحية ذاتها.
الجماعة التي تأسست في الأربعينات، وتدرّبت لعقود على فنون المراوغة السياسية والعمل من تحت الأرض، لا تملك رفاهية المفاجأة، ولا تُجيد مشهد الوداع. هي لا تنسحب من الساحة، بل تُغيّر مقعدها، تدخل من كواليس المسرح كلما أُغلق الباب أمامها. ولأن الحظر ليس الأول من نوعه في تاريخها، فهي تدرك أن مواجهة مباشرة ستقود إلى انسداد جديد، فتفضّل الارتداد إلى الداخل.
تُظهر دراسات المراكز البحثية مثل Carnegie Middle East (2024) أن الجماعات التي تواجه الحظر التنظيمي تميل إلى إعادة التمركز في حقول يصعب ضبطها مثل الإعلام والثقافة، حيث تتحرك الأفكار دون عوائق قانونية مباشرة.
تقرير Chatham House (2025) يصف خطوة مثل حل جمعية الإخوان بأنها "إغلاق واجهة، لا إنهاء وجود"، مؤكدًا أن الجماعة تستعد لمرحلة "اللافتات البيضاء"، أي العمل عبر كيانات ثقافية وخيرية بلا هوية تنظيمية ظاهرة.

حلّ طوعي أم مناورة؟
الحظر الأخير لم يكن معزولًا عن سياق أمني متصاعد. القرار جاء بعد كشف السلطات الأردنية عن خلايا «إخوانية سرية» متهمة بالتنسيق لصناعة صواريخ وطائرات دون طيار، مع اعترافات شملت 16 موقوفًا بين 2021 و2025، وتفكيك شبكتين لنقل تمويل خارجي. وزير الداخلية صرّح بأن الجماعة «عبّرت عن نفسها في الظل» وحوّلت الفكر إلى «خطر أمني». التحقيقات كشفت أيضًا عن شبكة تمويل ضخمة: أكثر من 30 مليون دينار جُمعت في ثماني سنوات عبر تبرعات واستثمارات، منها 4 ملايين دينار في مداهمات نيسان وحدها، إضافةً إلى أصول تفوق 500 مليون دينار في قطاعات الصحة والتعليم ، ما يعكس مدى تغلغل الجماعة في الاقتصاد الخيري والتربوي. وتحت تأثيرها ما يقارب 30 منظمة تعليمية وصحية ونقابية، تمتلك قدرات تعبئة واسعة وقت الأزمات وساعات الحشد.
وسط هذه الضوضاء، أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخّصة قانونيًا في الأردن، الثلاثاء الماضي، حلَّ نفسها طوعًا، في خطوة بدت للوهلة الأولى نهايةً للمسار القانوني للجماعة، لكنها في العمق، كما وصفها خبراء حركات الإسلام السياسي، مناورة مكشوفة لتجنّب تبعات قرار الحظر الحكومي الأخير، والتموضع مجددًا في مساحات أقل مراقبة. فحلّ الكيان القانوني يمنح التنظيم فرصة التخلص من الأعباء المالية والرقابية، والتحرر من قيود التشريعات التي باتت تحاصره، دون أن يعني اختفاء المشروع الإخواني نفسه.

استراتيجية الواجهات الناعمة
يشير الباحث لورنس روبين في دراسة صادرة عن RAND (2023) إلى أن الإخوان المسلمين طوّروا منذ التسعينات ما يسميه بـ"استراتيجية الواجهات الناعمة"، أي العمل عبر مؤسسات ثقافية وخيرية وإعلامية بلا هوية تنظيمية واضحة، لتجنّب الرصد الأمني وإعادة إنتاج خطابهم بهويات جديدة. هذا ما يفسّر لجوءهم، بعد قرار الحظر الأخير وحل الجمعية المرخصة، إلى التسلل عبر منصات الثقافة والإعلام، حيث تُقدَّم رسائلهم كمنتج معرفي أو أخلاقي، في حين تحمل في طياتها البنية الأيديولوجية للجماعة.
ويرى محللون أن الجمعية، التي حصلت على الترخيص عام 2015 بعد انشقاقها عن الجماعة الأم، قررت إنهاء وجودها التنظيمي لتجنب ملاحقات قانونية وامتصاص الإجراءات المشددة على التمويل ومصادره، فيما توقّع سياسيون أردنيون تشديد الرقابة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، لكنهم استبعدوا حظره ما دام ملتزمًا بالقوانين.
ويصف خبراء مثل هشام النجار هذه الخطوة بأنها "هروب للأمام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، بينما يرى منذر الحوارات أنها مقدمة لظهورٍ جديد "بأسماء وشخصيات مختلفة لتجميد تبعات الماضي". وتؤكد تحليلات Chatham House أن الحظر الأخير يمثل بداية لتوجه جديد نحو العمل الثقافي كمساحة أخفى، تستغل ضعف الرقابة الرسمية وتحسّب السلطات لهذا المنعطف بإغلاق الباب السياسي فقط.
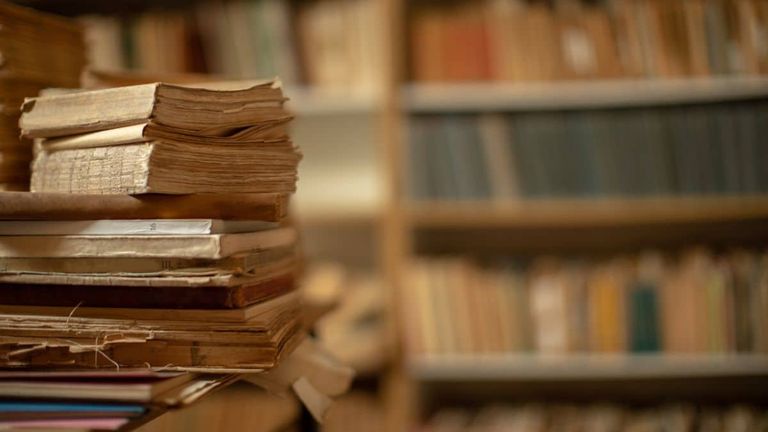
غبار التنظيم على ورق الحكاية
يبرز المشروع الذي ظل لسنوات طيَّ الكتمان، وكأن الجماعة لا تريد الاعتراف به إلا حين تعجز عن التعبير في الميادين الكبرى. مشروعها الثقافي، الذي اتخذ من الأدب غطاءً، لا يحمل شعارات، ولا يُطلّ برموزه. روايات ومقالات ونصوص، تُغلف الخطاب السياسي بورق الفن، وتُذيب الأيديولوجيا في ماء الشعر. تسحب القارئ إلى مناخ ديني متسامٍ، لتغرس داخله سردياتها السياسية دون أن يلحظ.
في معرض عمّان للكتاب، برزت روايات «قصة الإيمان في زمن الصمت» و«قلم مؤمن» كأدب ديني ملتزم، لكن تقارير أمنية أكدت أن نصوصها تحمل البنية الأيديولوجية للجماعة. مجلات مثل «مجلة العلم الناشط» و«منشور الفكر الأخلاقي» تُوزع في الجامعات والمعارض كعناوين ثقافية مستقلة، بينما تقف خلفها شبكة توزيع بلا هوية تنظيمية واضحة. وتؤكد السلطات أن جزءًا من الـ30 مليون دينار المجمّعة وُجّه لاستدامة هذه المنظومة الثقافية.
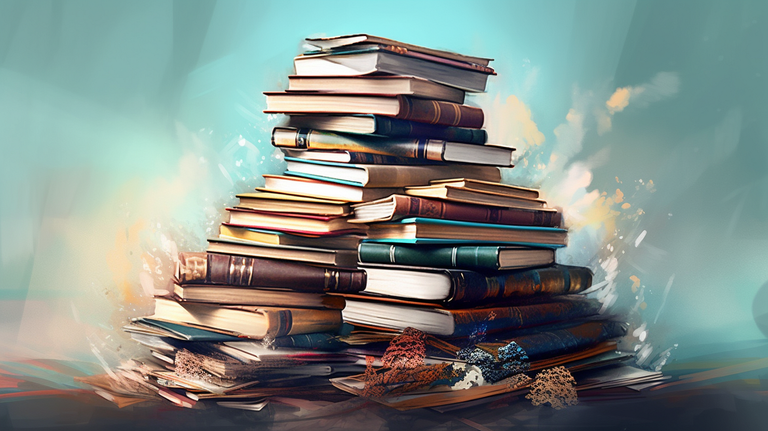
شبكة نشر الملابس البيضاء
وفي عالمٍ تتشابك فيه اللحى بالأيديولوجيا، وتتحوّل فيه الرواية إلى بيان، والقصيدة إلى منشورٍ حزبيّ مموّه. في هذا الهجين العجيب بين الدين والسياسة، لا تجد جماعة الإخوان المسلمين ضالتها في المواعظ وحدها ، تعمل الجماعة عبر شبكة دور نشر ومحافل ثقافية، تطلق كتبًا وروايات في معارض عربية بتوزيع موحد، ممولة ضمن شبكات خفية. «السبيل»، الأسبوعية الإسلامية التي تأسست عام 1993، تحولت إلى يومية عام 2009 ووصل تداولها إلى نحو 17 ألف نسخة عام 2002، لتصبح واجهة إعلامية بارزة، ورغم التضييق بعد 2023، بقيت مثالًا لواجهة ثقافية «ملتزمة» تحولت لفضاء دعوي مقنّع. ندوات شعرية ومناقشات أدبية تُدار بأسماء مستقلة لكنها معروفة بقربها من الجماعة، تستهدف الطلبة والمثقفين، ضمن خطة «إعادة الإنتاج الثقافي من تحت الأرض». ووفق المقارنات، تتكرر الاستراتيجية نفسها في مصر عبر مؤسسات ثقافية في المهجر، وفي المغرب حيث استغلت الجماعة دعمًا خيريًا إسلاميًا ضمن بيئة أقل رقابة.
لم تكتف الجماعة بتكوين التنظيم، بل صاغت خطابًا ثقافيًا موازيًا، يتسلّل إلى الوعي كالماء بين الأصابع. أدبٌ يُنشر لا على أنه سياسي، بل إسلامي، أخلاقي، ملتزم، بينما هو في جوهره مجرّد أداة جديدة في ترسانة الدعاية، يتخفّى خلف القيم، ويتلحّف بثياب الإيمان، وهو يسوق عقيدة جماعة، لا عقيدة أمة.
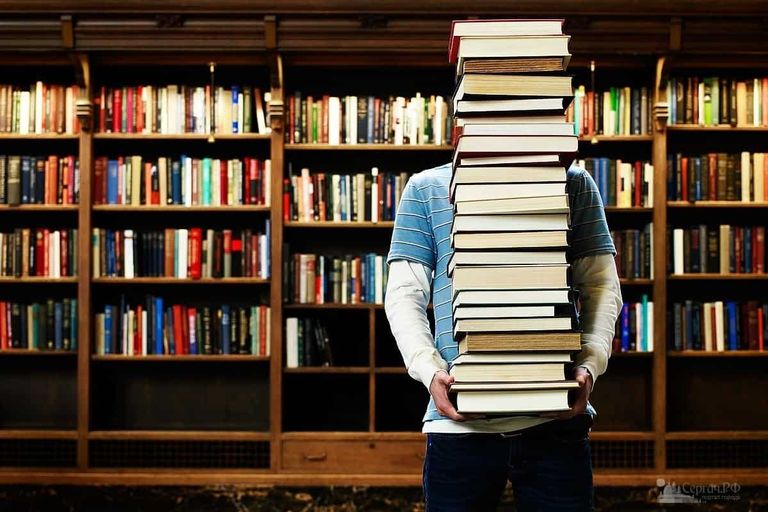
السطر الخلفي للبيان
حتى في صفحات الإخوان المسلمون «أحداث صنعت التاريخ»، يكشف محمود عبد الحليم كيف رأى حسن البنا في مصطفى صادق الرافعي نموذجًا يُحتذى به. لم يكن البنا يرى الأدب إبداعًا حرًا، بل وسيلة دعوية. كان يُربّي الأدباء كما يُربّي الدعاة، ويرى في المذياع والصحافة أدوات نشر للدعوة، لا للثقافة.
هذه النمطية تُظهرها مصادر حقوقية أردنية أيضًا: اعتقال قادة في التعليم والنقابات والاتحادات، وُصِفوا بأنهم ينتمون لهيكل إخواني سري استُخدم للحشد التنظيمي في السنوات الماضية. هذا الإدراك امتد ليصبح قاعدة: الدعوة ليست خطبة على منبر، بل رواية في معرض، ومقال في مجلة، وقصيدة تُغنّى بلهجة شاعر مؤمن. الأدب صار واحدًا من مفاتيح التجنيد الثلاثة التي يتحدث عنها الباحثون: نشر الدعوة، الربط العام، والدعوة الفردية.

دعوة تُكتب بالحبر
في المسافة بين من يكتب حريته الشخصية، وبين من يكتب بتكليفٍ تنظيمي، يكمن الفارق بين أدب ينشأ من القناعة، وآخر يُبنى على خطة. الأدب المقاوم، على ما فيه من أيديولوجية مفرطة، قد يخالفه الكثير، لكنه ابن حريته، أما الأدب الإخواني، فهو ابن اجتماع تنظيمي وجدول توزيع وقرار مركزي.
وقد لاحظ المحللون أن الحظر السياسي لا يغلق إلا الطرق الرسمية، بينما الأدب والثقافة تبقى فضاءات لا تطالها عين الدولة بسهولة، ما يجعلها ميدانًا فعليًا لتسريب الرسالة الجماعية بدون إعلان. ودعم حملات شبابية ونقابية واستثمارها في إنتاج ثقافي وأدبي لاستدامة التأثير رغم احظر. كل شيء مخطط ومحسوب وموجَّه، والكتاب الذي يَلقى رواجًا، يُعاد طبعه وتكليفه بمنشور جديد، فيتحول إلى أداة تعبئة مقنّعة بغطاء ثقافي ودعوي.
الأدب كملاذ أخير للجماعة
هذا المشروع لا يهدّد الأدب فحسب، بل يهدد الوعي. إذ يُخلط بين أدب ملتزم نابع من رؤية إيمانية حرّة، وبين نصوص موّجهة تخدم مشروعًا سياسيًا يتخفّى خلف الدعوة. والخطر لا يكمن في وجود هذا الأدب، بل في غياب القراءة النقدية له، وعدم فرز ما هو دعويّ عفويّ، مما هو أداة تعبئة بغطاء إسلامي. هنا تبرز الحاجة الملحّة، لا لحظر هذا الأدب، بل لقراءته بأدوات مزدوجة: عين ناقد أدبي، وعقل باحث في التنظيمات. لفهم ما يُقال، وما يُخفى، وما يُقصد. لأن الحكاية – حين يكتبها التنظيم – لا تكون أدبًا، بل خطابًا بأقلام مستعارة، ومشروعًا بثلاثة وجوه: أخلاقي، ودعوي، وسياسي. وفي النهاية، يبقى السؤال: من يكتب لمن؟ وهل نقرأ رواية.. أم نُعيد قراءة الجماعة نفسها؟
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTMg جزيرة ام اند امز