من الكساد إلى كوفيد.. تاريخ الأزمات الاقتصادية الكبرى

الأزمات الاقتصادية والمالية لم تكن في أي وقت مجرد أحداث عابرة في مسار الاقتصاد العالمي، بل شكلت محطات فارقة تركت بصماتها على السياسات والأنظمة الاقتصادية، وغيرت من مصائر الشعوب والدول على حد سواء.
ورغم أن أسبابها قد تختلف ما بين الحروب والمضاربات المالية والسياسات النقدية الخاطئة أو حتى الأوبئة العالمية، فإن نتائجها غالبًا ما تتشابه في صورة انهيارات حادة في الأسواق، وارتفاع معدلات البطالة، وتبخر الثروات، وتراجع الثقة في المؤسسات.
الكساد الكبير 1929
يعد الكساد الكبير الذي بدأ بانهيار بورصة وول ستريت في أكتوبر/تشرين الأول 1929 نقطة تحول محورية في تاريخ الاقتصاد العالمي، فقد انطلقت شرارة الأزمة في ما عرف بالثلاثاء الأسود، حين عرض ملايين المستثمرين أسهمهم للبيع وسط ذعر جماعي، دون أن يجدوا مشترين.
ومع تواصل عمليات البيع انهار مؤشر داو جونز ليخسر ما يقارب 90% من قيمته خلال ثلاث سنوات فقط، وتزامنًا مع إفلاس آلاف البنوك الأمريكية، وتراجع التجارة العالمية بما يقارب الثلثين، وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية إلى أقل من نصف قيمتها، في حين تجاوزت معدلات البطالة ربع القوة العاملة في الولايات المتحدة.

تجاوزت آثار الأزمة حدود أمريكا، إذ انسحبت الولايات المتحدة من إيداعاتها في أوروبا، ما أدى إلى شلل مالي أصاب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأسهم في صعود الأنظمة المتطرفة مثل النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا.
وعلى المستوى الداخلي الأمريكي، شكل الكساد لحظة مفصلية أطلقت خلالها إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت "الصفقة الجديدة" التي أعادت تعريف دور الدولة في الاقتصاد، من خلال الرقابة على البنوك، وإنشاء مؤسسات للرعاية الاجتماعية، وفتح الباب أمام مشاريع ضخمة لتشغيل العاطلين.
أزمة النفط 1973
بعد عقود قليلة، شهد العالم أزمة مختلفة تمامًا حين تحولت الطاقة إلى أداة سياسية واقتصادية، فتزامنًا مع حرب أكتوبر 1973، فرضت دول منظمة أوبك بقيادة السعودية حظرًا على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل.
لم يستغرق الأمر سوى أشهر قليلة حتى تضاعفت أسعار النفط أربع مرات، ودخلت الاقتصادات الغربية في حالة غير مسبوقة من "الركود التضخمي" الذي جمع بين الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في الوقت نفسه.
هذه الأزمة لم تكن مجرد تقلب عابر في أسعار الطاقة، بل شكلت نقطة تحول دفعت الدول الغربية إلى إعادة النظر في سياساتها الطاقوية، فاتجهت إلى البحث عن بدائل للنفط، وتوسيع استثماراتها في الطاقة النووية والمتجددة، وهو مسار لا يزال أثره ممتدًا حتى اليوم.

أزمة ديون أمريكا اللاتينية
في ثمانينيات القرن العشرين برزت أزمة جديدة، هذه المرة في أمريكا اللاتينية، حيث وجدت دول المنطقة نفسها غارقة في ديون هائلة بعد سنوات من الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، أصبح من المستحيل على هذه الدول خدمة ديونها. كانت المكسيك أول من أعلن عجزه عن السداد عام 1982، وتبعتها البرازيل والأرجنتين، مما دفع المنطقة بأكملها إلى أزمة اقتصادية خانقة أفقرت ملايين السكان.
أدت هذه الأزمة إلى بروز دور صندوق النقد الدولي، الذي تدخل ببرامج تقشف وإعادة هيكلة قاسية، تركت آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة ما زالت حاضرة في الذاكرة السياسية لشعوب المنطقة.
الإثنين الأسود 1987
في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 1987، عاشت أسواق المال العالمية صدمة كبرى حين فقد مؤشر داو جونز أكثر من اثنين وعشرين في المائة من قيمته في جلسة واحدة.
كان ذلك الانهيار الأسرع في تاريخ البورصات الأمريكية، حيث بدأ من هونغ كونغ وانتقل بسرعة إلى أوروبا وأمريكا، ساهمت المضاربات المفرطة واستخدام الحواسيب في أوامر البيع التلقائي في تسريع الانهيار، إلى جانب المخاوف من عجز الميزان التجاري الأمريكي.
ورغم الحدة المفرطة لتلك الأزمة، فإنها ظلت في إطار الأسواق المالية أكثر من الاقتصاد الحقيقي، حيث تمكنت الأسواق من استعادة عافيتها في غضون عامين فقط، ما جعلها تُصنف كأزمة مالية وليست اقتصادية شاملة.
الأزمة المالية الآسيوية 1997
شهد العالم عام 1997 أزمة اجتاحت اقتصادات جنوب شرق آسيا، حين انهارت العملة التايلاندية بعد هجمات مضاربة عنيفة، وسرعان ما امتد الانهيار إلى إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية، وفقدت العملات قيمتها بشكل دراماتيكي، وتراجعت أسواق الأسهم، وتدفقت رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، ما أدى إلى ركود اقتصادي حاد ألقى بملايين العمال في البطالة.
هذه الأزمة كشفت هشاشة الاقتصادات الناشئة أمام حركة رؤوس الأموال العالمية، ودفعت صندوق النقد الدولي إلى التدخل بحزم إنقاذ ضخمة رافقتها برامج إصلاح اقتصادي صارمة. لكنها أيضًا جعلت دول آسيا أكثر حذرًا في تعاملها مع أسواق المال، فعمدت لاحقًا إلى بناء احتياطيات نقدية ضخمة كخط دفاع أمام أي تقلبات مستقبلية.
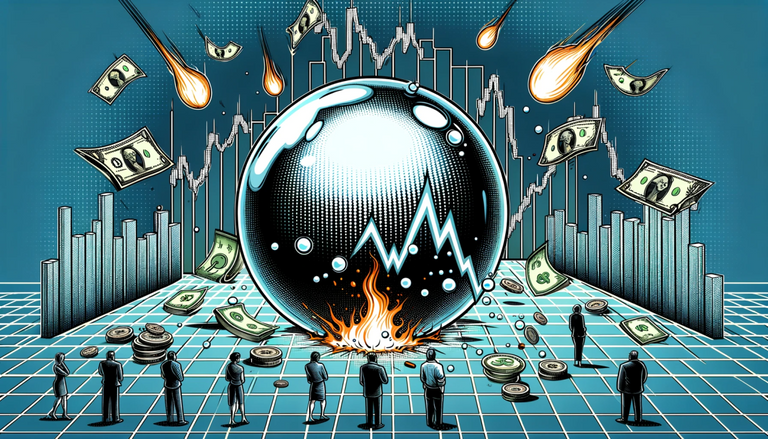
فقاعة الدوت كوم 2000
مع صعود الإنترنت في التسعينيات، شهدت الأسواق العالمية اندفاعًا غير مسبوق نحو شركات التكنولوجيا الناشئة، ولم تكن تلك الشركات تحقق أرباحًا حقيقية، لكن المضاربات رفعت قيمتها السوقية إلى مستويات فلكية.
وفي مطلع الألفية انفجرت الفقاعة، فتراجع مؤشر ناسداك بشكل حاد، وانتهت حياة مئات الشركات التي لم تصمد أمام الواقع. ورغم الخسائر الكبيرة، أفرزت الأزمة تجربة مختلفة، إذ برزت شركات قليلة نجت واستطاعت أن تتحول إلى عمالقة الاقتصاد الرقمي مثل أمازون وغوغل.
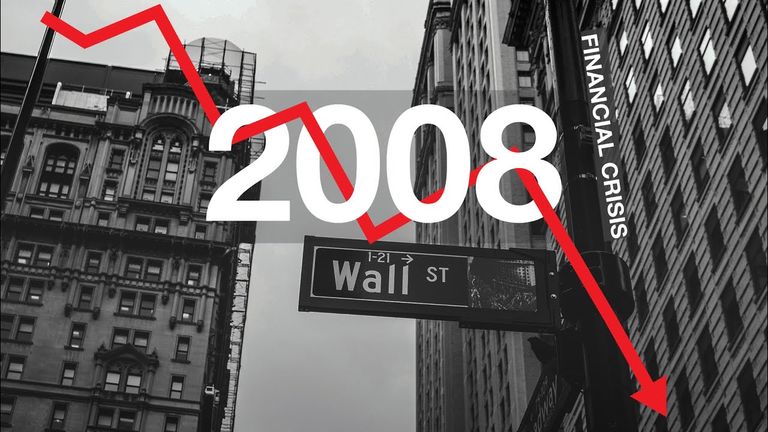
الأزمة المالية العالمية 2008
الأزمات السابقة بدت صغيرة مقارنة بالأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي وُصفت بأنها الأسوأ منذ الكساد الكبير. بدأت الأزمة في الولايات المتحدة نتيجة التوسع غير المحسوب في سوق الرهن العقاري عالي المخاطر، وانهارت معها مؤسسات مالية كبرى أبرزها بنك ليمان براذرز.
ومع الانهيار تهاوت البورصات العالمية، وخسر مئات المليارات من أغنياء وول ستريت في أيام معدودة، بينما فقد أكثر من ثمانية ملايين أمريكي وظائفهم، وتمت مصادرة ملايين المنازل.
انتقلت الأزمة بسرعة إلى أوروبا، حيث دخلت دول مثل اليونان وأيرلندا في أزمات ديون سيادية استلزمت خطط إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولولا التدخل الحكومي المباشر عبر خطط إنقاذ وتحفيز ضخمة، لربما تحولت الأزمة إلى كساد عالمي جديد.
أزمات حديثة
لم يتوقف العالم عند أزمة 2008، ففي عام 2020 ضربت جائحة كورونا الاقتصاد العالمي ضربة غير مسبوقة، حيث توقفت سلاسل الإمداد، وأغلقت الحدود، وتراجعت التجارة الدولية إلى مستويات خطيرة، ففقد ملايين وظائفهم، واضطرت الحكومات إلى ضخ حزم مالية هائلة لدعم الأسر والشركات.
هذه السياسات خلفت تضخمًا عالميًا سرعان ما ظهر بقوة في 2021 و2022، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم أزمة الطاقة والغذاء، وتعيد التضخم إلى الواجهة وسط مخاوف من دخول العالم في مرحلة ركود تضخمي شبيهة بما حدث في السبعينيات.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg
جزيرة ام اند امز






