الروائي إلياس فركوح لـ"العين الإخبارية": أكتب بأثر من يقين مفقود

الروائي الأردني إلياس فركوح يؤكد أن دراسته للفلسفة أفادته كثيرا في كتابة أعماله خاصة فيما يخص القدرة على بلورة رؤيته للعالم
يرى الروائي الأردني إلياس فركوح أن القصة القصيرة، كجنس أدبي، تراجعت أمام الرواية، ليس فقط على مستوى القراءة، ولكن أيضًا على مستوى كتابتها، لافتا إلى أن الجوائز الأدبية المخصصة للرواية باتت أمرا يستحق البحث والدراسة.
وأكد فركوح الذي يشارك حاليا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في حواره لـ"العين الإخبارية"، أن دراسته للفلسفة أفادته كثيرا، خاصة فيما يخص القدرة على بلورة رؤيته للعالم.
وأوضح صاحب رواية "أرض اليمبوس" أن تجربته كناشر في دار أزمنة جعلته يكتسب الخبرة، حيث إن الناشر العارف بالثقافة وأحوالها غالباً ما يتمتع برؤية براجماتية، وفق تعبيره، تجنبه الوقوع في مآزق مالية، والسبب إتاحته لنصوصٍ قد لا تكون متماسكة فنياً، لكنها تلبي رغبة السوق وراهنيته، دون أن تعاني بالضرورة من الركاكة.. وإلى نص الحوار:
- تحضر الأسئلة الفلسفية في أعمالك بشكل واضح.. هل يعود ذلك لدراستك للفلسفة أم لطبيعتك النفسية فتكون دائم السؤال تبحث دائماً عن إجابات لا تنتهي؟
لن أكون على قَدْرٍ من الوثوق إذا ما أجبتكَ موافقاً على هذا، أو نافياً لذاك. ولأنّ هذه المسألة/الحالة قابلة للتقليب فيها وإمعان الاجتهاد بجوانب أسبابها وخلفياتها، أراني أُشرككَ (ولو بالتلميح الخاطف) في عملية استرجاع طبيعة "الجبلة" التي تأتت عن تاريخٍ شخصي لا بُدّ من تأمله – ولو خَطْفاً. لا بُدّ من ذلك، لأنّ بإمكاننا، من خلال هذا الاسترجاع لذاك التاريخ، الوقوع على "شيءٍ ما" من "حقيقةٍ ما" تخصُّ شبكة سؤالك.
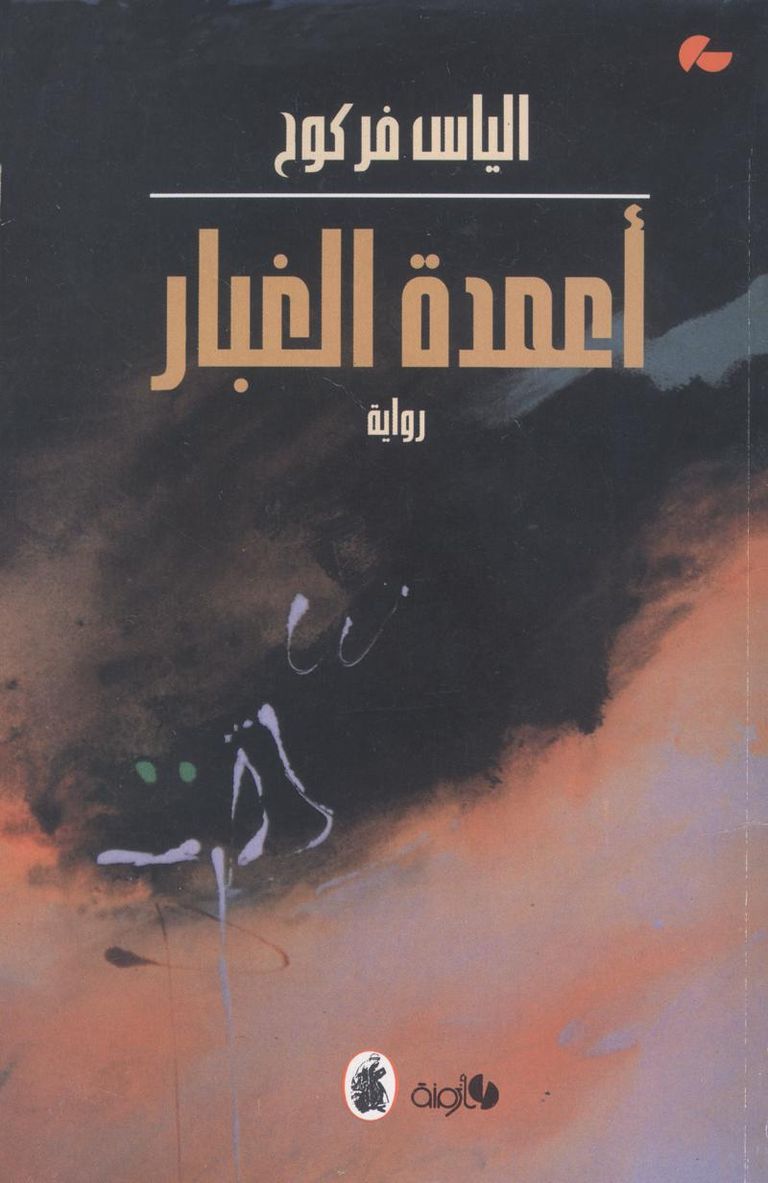
دراستي للفلسفة، كما أعتقد، لعبت دوراً في تشكيل عدة عناصر ذات صِلة بي، كشخصٍ وككاتب، لكنه ليس دوراً تأسيسياً. كما لم يكن للفلسفة، كدرسٍ أكاديمي، تأثيرها في وعيي الكُلي بقدر ما كانت، وما زالت، تعينني على تنظيم وبناء الجُمَل والفقرات في كتابتي، عموماً، على نحوٍ منطقي ومتسلسل. بمعنى الحرص على "كتابة واعية" ضابطة لا مكان فيها لأي إسهابات واسترسالات وإطنابات تعمل على "ترهل" نصوصي، وربما يكون هذا أحد ملامح كتابتي. وإني، حين أشير إلى "كتابة واعية"، فإنما أقصد الاحتكام إلى "لغة" تحمل وجْهَي العملة الواحدة: تارةً ذات حَواف وزوايا لا تحتمل "التدوير والتليين"، وتارةً مخاتلة تلقي بظلال المعاني على "الكلمة والجُملة" لتحيلهما على "قارئ" يجتهدُ، ويشارك، ويذهب بالنصّ نحو أبعاد وآفاق مفتوحة.
نعم؛ كان للفلسفة أن أسعفتني في "إدخال" منطق لغتها وتسريبه داخل مفاصل كتابتي الأدبية. وربما عملَت، أيضاً، على مساعدتي في بلورة رؤيتي للعالم ووعيي عليه بصياغته وفقاً لـ"منطوق لغتها" البائن في قلب سرد أدبي روائي وقصصي.
أما عن الأسئلة؛ فتلك نتيجة ما جابهتني به الحياة من إجاباتٍ واهية، إجابات بحاجة إلى مَن "يستنطقها ويستجوبها"، إذ فقدَ العالمُ مرتكزات الوثوق به وبطروحاته، ومن صميم ما قلته الآن يمكنك النظر إليَّ ومعاينتي شخصاً يكتب بأثَرٍ من "يقينٍ مفقود"، يقين عتيق استراحت إليه طفولةٌ ونشأةٌ أُولى ما لبث أنْ أضاعته انكساراتُ الشباب، وهزائم النضوج، وخسوف كلّ "الجِنان الموعودة"! وإني هنا تحديداً إنما أشير إلى تاريخي الشخصي، غير المنفصل أبداً عن تاريخ أبناء جيلي وبَلَدي. وإنها لـ"جبلة" غير قابلة للتفتت.
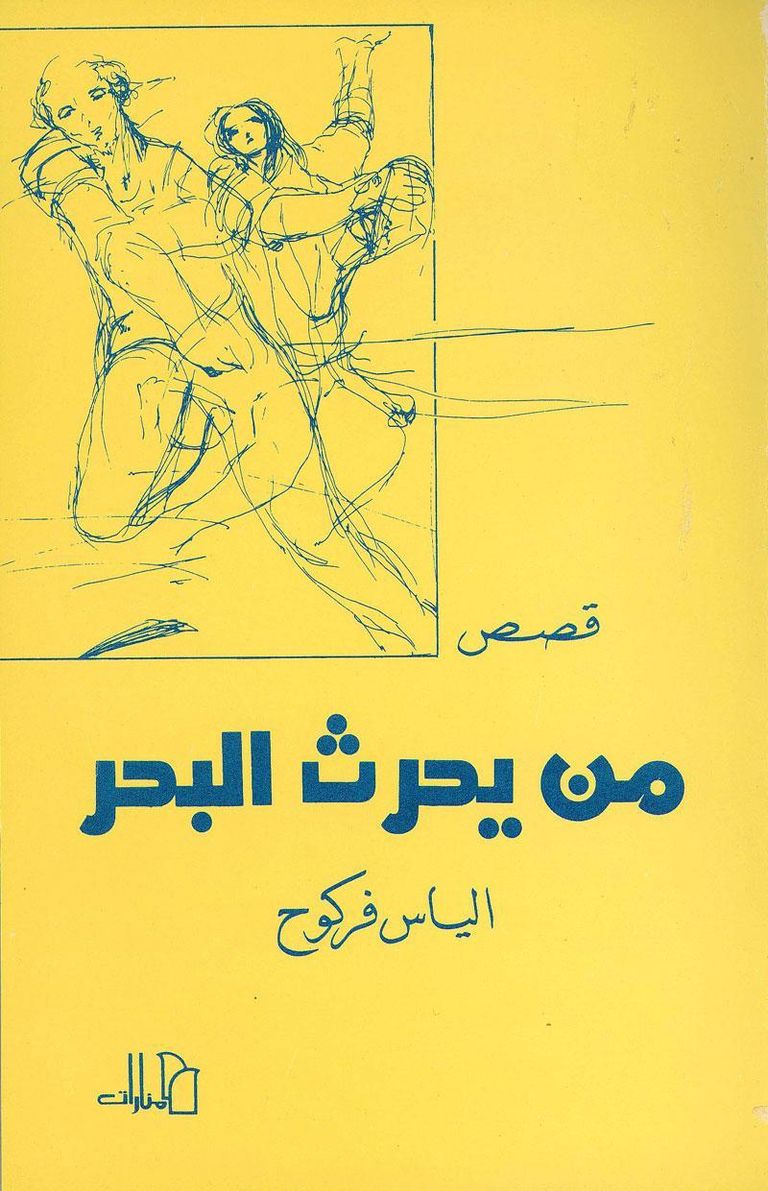
- وصلت روايتك "أرض اليمبوس" للقائمة القصيرة للبوكر العربية عام 2008.. هل يمكن أن ننظر للرواية على أنها (أرض البين بين)؟ هل تفضل الإقامة في منطقة كهذه؟
لا أحد بلغَ به العُمْرُ والتجربة مبلغَ ما وصلتُ إليه، وما يزال يفتقد رؤية واضحة للعالم، أو لموقف مبدئي من قضاياه. هذه مسألة غير واردة بالتأكيد، وتجافي صيرورة الكائن الإنساني ومنطقه. ولأنّ الأمر هكذا؛ أراني أنفرُ من المواقف الحائرة حين يتطلّب السياقُ العام حسماً، وصراحة، وصوتاً لا لبس فيه. هذا على صعيد العَيش اليومي والتعامل المباشر مع الناس في حياتنا العادية. غير أنّ الانتقال من الواقع المعيش الملموس، الذي يبدو متماسكاً في ظاهره، إلى تأمله في عُمق تفاصيله عبر الكتابة؛ أكون مضطراً لأن أقوم بـ"تفكيكه" بطرح الأسئلة عليه.. وعليَّ أيضاً، في الوقت نفسه. وإنها نوعٌ من الأسئلة التي ربما لا إجابات شافية عنها تمنحها لنا الوقائع "خارج الكتابة"، لأنها (الوقائع) ترجمة لمجموعة تناقضات ليس سهلاً فهمها لأنها ناتجة عن قرارات، أو مسلكيات، أو ردود أفعالٍ مجموعة من الناس لا نتعامل معهم إلّا بوصفهم أفراداً، أو لِنَقُل ذوات لكلِّ ذات تاريخها الشخصي وعالمها الخاصّ. عالم مُغْلَق، أو موارَب، أو مفتوح.
حين يتعلق الأمر –أيّ أمر– بالإنسان كفردٍ وذات، ونبدأ بالتعامل معه عبر الكتابة؛ عندها نكون دخلنا "أرض اليمبوس"، أو بالأحرى "أرض الأسئلة"!
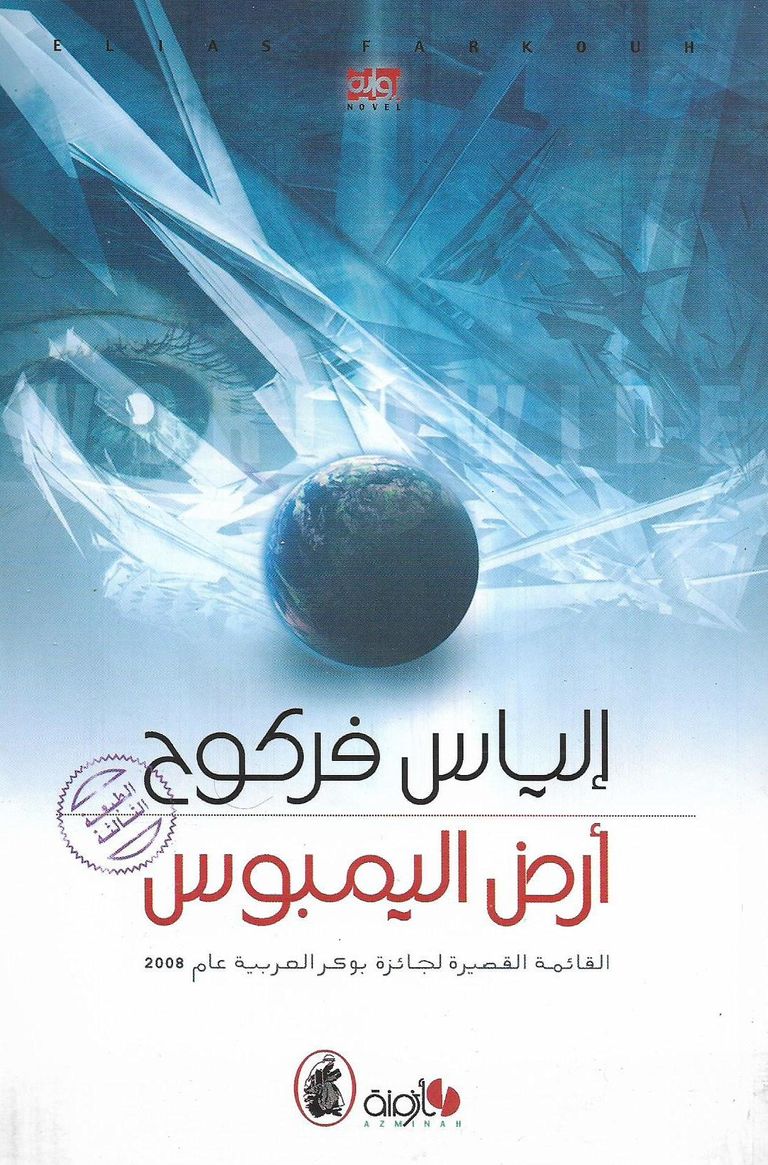
- هل أسهمت الجوائز الأدبية في الترويج للرواية؟
بالإجمال، أعتقد أنّ هذه الحالة باتت قائمة. نعم، أسهمت الجوائز الأدبية في إشاعة وترويج الروايات المكتوبة في أقطار عربية لم تكن ذات حضور واضح على خريطة الرواية العربية عموماً. إضافة إلى أن هذه الجوائز أدّت دوراً مهماً في "إبراز" الحالات الإبداعية المتميزة لكتّاب وكاتبات نُظِرَ إلى بلدانهم كـ"أطراف"، بالمقابل من "مراكز" استحوذت تاريخياً على المساحة الأكبر من المشهد الثقافي العربي.
ثمّة حالة من إعادة ترتيب و"توازن جديد"، معرفياً وفضولا، أشاعتها الجوائز تجلّت في توسعة خريطة القارئ العربي وأجندة مطالعاته، وفي تعدد نقاط ارتكازاتها.
- هل مقروئية القصة القصيرة تتراجع أمام الرواية بسبب اهتمام الجوائز بالرواية أم لأن مزاج القارئ بشكل عام ينجذب للرواية على حساب القصة؟
لم تتراجع مقروئية القصة القصيرة، مقارنة بالرواية وامتداداتها فحسب؛ بل تراجعت أيضاً على صعيد كتابتها. وإني هنا أنطلق من رصدي العام للتناقص في عدد المجموعات القصصية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وكذلك في تحوّل نسبة من كُتّابها إلى الرواية. غير أنني أتردد إذا ما قلتُ إنّ الجوائز الخاصّة بالرواية، والتي باتت "ظاهرة" تستحق الدراسة، هي السبب الوحيد، وإنْ كانت ذات تأثير لا يُنْكَر وجَذْب لجيلٍ جديد من الكتّاب. فالمزاج العام، في رأيي، يخضع للتحوّل متأثراً بالإعلام ووفقاً لمؤشر بوصلته، فما بالك إذا صادقْنا على أنّ "هذا المزاج" يتم تخليقه وتأسيسه كأنه "ميراث" كلّ عقد أو عقدين!
رغم كلّ ما سبق، وبسبب كلّ ما سبق أيضاً، أجدُ أنّ النقطة الأهمّ هي التنبُّه للتحوّلات التي أصابت القصة القصيرة، بوصفها جنساً فنياً متحركاً ومتنوعاً في أشكال كتابته، وأنّ تراجعه على صعيد المقروئية بمنطق الإحصاء، والكتابه أيضاً، لا يعني تراجع استحداثاته في داخله، فثمّة حراك يحدث داخل بنية القصة القصيرة، يصل في بعض التجارب إلى نصوص "متطرفة" تحتاج إلى ما يبررها لذائقة قارئ عليم! ومع ذلك تراها راجت وسط طوفان الرواية، بينما لم تنقطع نماذج تتحلّى بجماليات القصة وإمتاعها أبقت على مألوف أشكالها إلى حدّ كبير، ومنها "في مستوى النَظَر" لمنتصر القفاش 2012، و"حروب فاتنة" لحسن عبدالموجود 2018، في مصر، و"مصعد مزدحم في بناية خالية" لنبيل عبدالكريم 2016، و"مراودات" لهيفاء أبو النادي 2016، و"جِوار الماء" لأماني سليمان داود 2018 في الأردن. وجملة قصص زياد خدّاش في فلسطين.
وهنا أجدني داعياً لـقراءة "الرؤية" الكامنة في النصوص وفي كُتّابها، أكانت رواية أو قصة قصيرة، ولقد تراجعت مقروئية القصة القصيرة إحصائياً، لكنها لم "تنسحب"؛ إذ هي "لم تخسر" إبداعاً ومبدعين.
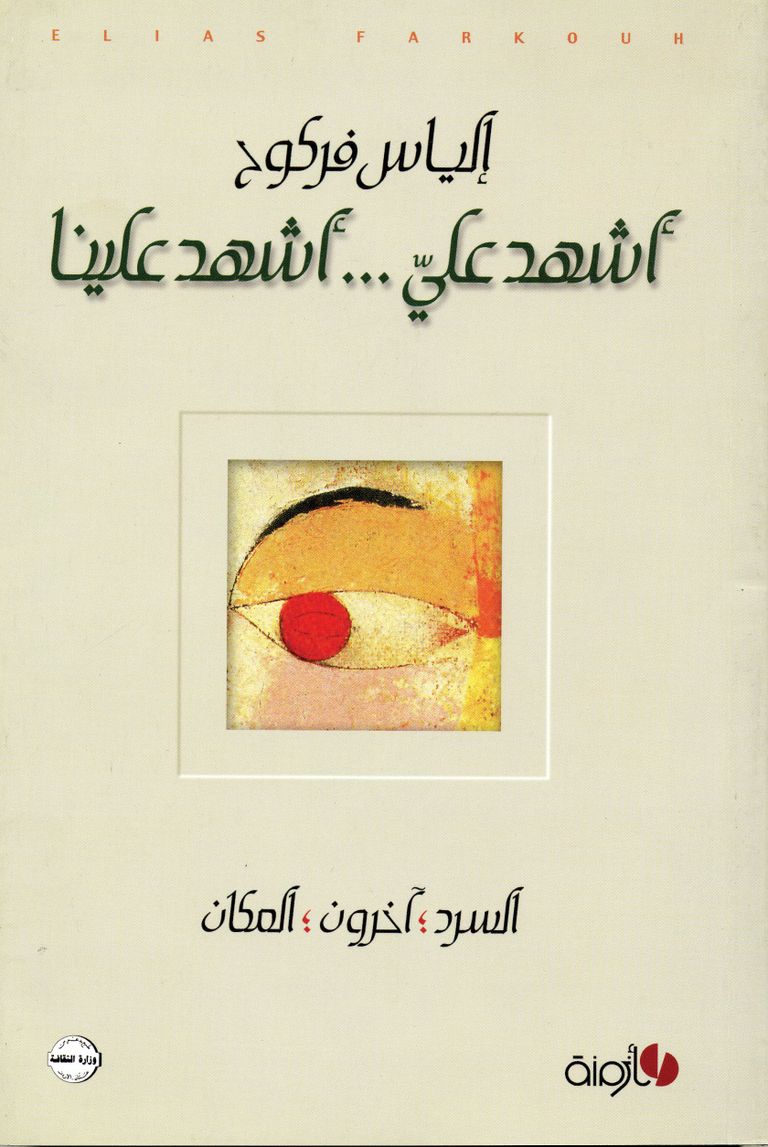
- خضت تجربة النشر عبر دار أزمنة.. ما الفارق بين أن يكون الناشر رجلاً عارفاً بالثقافة وأحوالها وأن يكون كاتبا بالأساس؟
لن يكون الفارق بين هذين الاثنين كبيراً، فالثقافة تجمعهما، ما يعني أنّ اختياراتهما من الكتب المنشورة تلتقي عند نقطة ما هو مُهم، وراهن، ومعرفي، استناداً إلى ما يملكان من إطلاع على الكتابات الجديدة، وعلاقاتهما مع الأوساط الثقافية. غير أني أعتقد، بحسب تجربتي الشخصية، أنّ الناشر الكاتب أكثر قدرة على الحكم والتقييم، وبالتالي فإنَّ اختياراته ستتحلّى بدقة أعلى فيما يخصّ النصوص الأدبية، مشروطة بالسويَّة الفنيّة وتميّزها على صعيد الجِنس الكتابي.
هذا ما لاحظته عبر سنوات تجربتي في دار أزمنة، آخذاً بالاعتبار أنَّ الناشر العارف بالثقافة وأحوالها غالباً ما يتمتع برؤية براجماتية تجنبه الوقوع في مآزق مالية، كالتي يعاني منها الناشر الكاتب. والسبب، كما أسلفت، إتاحته لنصوصٍ قد لا تكون "متماسكة" فنياً، لكنها تلبي رائجَ "السوق" وراهنيته، دون أن تعاني بالضرورة من "الركاكة".
- ماذا تكتب الآن؟
بصراحة: لا شيء يستحق الاستفاضة بالحديث عنه، أو الإشارة إليه. ربما أمارسُ ما وصفه صديقٌ لنفسه حين قال: أكتبُ في مخيلتي من دون أوراق!
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTYg جزيرة ام اند امز





