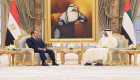مصر دخلت مرحلة جديدة في سياساتها الخارجية، تبدأ من واقع أن البناء الداخلي هو حجر الأساس في حماية مصر
خلال الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر الجاري عقد مركز أبوظبي للسياسات مؤتمره السنوي "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس" تحت عنوان "تنافس القوى القديم في عصر جديد". وكما هي العادة في مثل هذه المؤتمرات فإنها تغطي عددا كبيرا من الموضوعات التي تخص النظام العالمي، والآخر الإقليمي الشرق أوسطي، والثالث الذي يركز على قضايا بعينها مثل القضية الفلسطينية، والتطورات التكنولوجية الجارية. وكانت المشاركة في هذه الفعالية مع عدد كبير من خبراء السياسة والاستراتيجية مصدرا لعدد من المقالات التي غطت موضوعاته المختلفة، ولكن هذا المقال على وجه التحديد سوف يركز على قضية جرى التعرض لها في أكثر من جلسة والمتعلقة بموقع مصر في التطورات الجارية في المنطقة. وكانت البداية في معرض الحالة في الإقليم، والخليجية على وجه الخصوص، وما تعرض إليه من اعتداءات من قبل طهران والحوثيون التابعين لهم في اليمن.
لم تكن مصر لا غائبة ولا مشلولة، ولكنها كانت تعمل من أجل تغيير واقعها، واللحاق بالعصر الذي تعيش فيه
كانت وجهة النظر التي جري التعبير عنها هي أن خللا قد جرى في توازن القوى أعطى لطهران ما يكفي لكي تقوم بالعدوان، سواء كان ذلك نتيجة الانسحاب أو الوهن الأمريكي في المنطقة، وأسباب أخرى كان من بينها "الغياب" المصري، أو ما أشار إليه أحد المشاركين بأن مصر باتت "مشلولة" أو "نصف مشلولة". والحقيقة أن مصر لا كانت غائبة ولا هي مشلولة، وإنما هي تعيش مرحلة عميقة من الإصلاح واسترداد العافية التي جعلتها في البداية تتخلص من حكم الإخوان، وما بعد ذلك التعاون مع الدول العربية الشقيقة، سواء كان ذلك ثقافيا أم اقتصاديا أم حتى عسكريا، بالكثير من المناورات العسكرية المشتركة التي لا تجرى كنوع من المظاهر وإنما تطبيقها في حال العدوان على الدول الشقيقة.
والحقيقة هي أن مصر دخلت مرحلة جديدة في سياساتها الخارجية، تبدأ من واقع أن البناء الداخلي هو حجر الأساس في حماية مصر وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعبئة البيئة الخارجية لدعم الداخل المصري. والحقيقة الثانية أن التركيز على البناء واكبه سياسات خارجية تقوم على التعاون والحد الأدنى من الاشتباك، فتحافظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وتدير قضية المياه مع إثيوبيا؛ حيث لا تقود إلى صراع وإنما إلى عمل مشترك، وإذا كان ضروريا كما هو الحال مع ليبيا فإن القوات المسلحة تستخدم بحزم وحساب ولإرسال الرسائل أن مصر قادرة على استخدام القوة عندما تقتضي الحالة.
هنا فإننا نجد الحركة المصرية النشطة تقتصر على الحدود المباشرة لمصر مع فلسطين وإسرائيل في الشمال الشرقي، ومع ليبيا في الغرب، ومع السودان وإثيوبيا وإرتيريا في الجنوب، هذه كلها تمثل القضايا المباشرة التي تتعلق بالأمن القومي المصري، وفيما عداها فإنها تلتصق مباشرة بعمليات البناء الداخلي، ومن ثم كانت هناك اتفاقيات تخطيط الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية التي فتحت أولا أبواب الاستغلال المصري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في البحر الأحمر، وثانيا أبواب تعمير سيناء، كما كانت اتفاقية تخطيط الحدود البحرية مع قبرص التي قادت إلى تنمية حقلي "ظهر" و"نور" للغاز، والتعاون في منطقة شرق البحر المتوسط في نقل وتسييل وتصنيع الغاز على الأرض المصرية، وإذا أخذنا كل ذلك مع تنمية إقليم قناة السويس فإن مصر تصير مركزا إقليميا للطاقة.
وإذا كان الجوار المباشر برا وبحرا يحدد النطاق الجغرافي للأمن القومي المصري المباشر، والذي قد يتطلب استخدام القوة العسكرية للدفاع عن المصالح المصرية العليا، فإن الإطار الجغرافي "ما بعد المباشر" في بقية المشرق العربي والخليج وشمال أفريقيا والعمق الأفريقي يحدد مناطق الاهتمام الدبلوماسي والسياسي والاستعداد المشترك مع الدول الشقيقة، والتأثير المصري من خلال التعاون المشترك، والتبادل التجاري، والقوة الناعمة المصرية.
ما بعد الجوار المباشر وغير المباشر فإن الحركة المصرية سوف تقوم على التعامل مع إقليم الشرق الأوسط والنظام العالمي كله من خلال سياسات خارجية حاذقة، تعمل على حماية المصالح المصرية العليا في الحفاظ على توازنات القوى إقليميا وعالميا، والاستفادة من التعاون الدولي لاستجلاب فرص اقتصادية وتكنولوجية مفيدة للعملية التنموية المصرية، ولتحقيق ذلك كله فإن هناك مجموعة من "المحركات Drivers" التي تقود الحركة المصرية خلال هذه المرحلة من تاريخها.
المحرك الأول يشكل فلسفة العمل المصري في "الكمون الاستراتيجي" الذي لا يعني السلبية ولا التراجع ولا الحياد، ولا يعني عدم احترام تعهدات مصر الدولية والإقليمية، وإنما يعني أمرين، أولهما أن الهدف الرئيسي للدولة هو التنمية والنمو إلى آفاق لم تعرفها مصر، ولكن تعرفها جيدا الدول التي سبقتها إلى التقدم والاستدامة، وثانيهما أن مصر لا تذهب في سياستها الخارجية بعيدا عن حدودها، والأهم بعيدا عن قدراتها القادرة على تعبئتها، سواء كانت القوة الخشنة أم الناعمة.
المحرك الثاني تغيير الخريطة أو الجغرافيا التنموية المصرية من التمحور حول نهر النيل الذي اعتمدت مصر عليه لآلاف السنين إلى البحار الواسعة ماء وضفافا المحيطة بالدولة. هذا الانتقال من "النهر إلى البحر" ليس إلغاء للحاجة والوجود في وادي النيل، وإنما هو خلق البراح اللازم للتعامل مع عشرات الملايين من المصريين، والتعامل مع موارد إضافية لم يعد النهر "الخالد" قادرا على مد مصر بها، العمران المصري لا يمكنه البقاء في حدود ٧% من مساحة مصر، وإنما عليه أن يمتد ليتجاوز ذلك بمسافات شاسعة.
المحرك الثالث هو اختراق الأراضي المصرية من سيناء إلى الصحراء الغربية، وهو ما يجري من إقامة مدن جديدة والأنفاق والطرق، لتأكيد ارتباط البلاد ببعضها بعضا.
المحرك الرابع فحواه "إدارة الثروة وليس إدارة الفقر"، فقد درجت الدولة المصرية خلال العقود الماضية على سياسات اقتصادية تمنع التراكم الرأسمالي، وتركز على محاولة حماية الفقراء بتقديم الطعام المدعوم، والطاقة المدعومة، والتعليم المجاني والصحة المجانية، والوظيفة الحكومية.. وهكذا أمور، حتى نضبت قدرة الدولة علي القيام بالواجب فزاد عدد الفقراء واشتد فقرهم، وقلّ تعليمهم وصحتهم، الآن فإن مصر تبحث عن "الثروة" في تعظيم مزاياها التنافسية إزاء العالم الخارجي في السلع والبضائع والخدمات والتكنولوجيا.
المحرك الخامس يقوم على ما جرى اكتشافه في جميع الدول التي كانت نامية وتقدمت، فنجد أنها توقفت عن سياسات "الإحلال محل الواردات"، واندفعت في اتجاه المحرك الخامس وهو التنمية من أجل التصدير.
المحرك السادس يقوم على أن المحركات الخمس السابقة ذات طبيعة مادية لها علاقة بتعبئة الموارد وعناصر القوة، ولكن الخمس محركات التالية تقوم علاقاتها على الاستخدام الأمثل لهذه المحركات، وهي بتعبير لغة الكومبيوتر هي "السوفت وير" الذي تكفل التشغيل والفاعلية. وهكذا فإن المحرك السادس يضم الحزمة الخاصة بالتعليم والصحة والثقافة، وجميعها تصب من زوايا مختلفة في "الحداثة"، ليس فيما يتعلق ببناء الدولة الحديثة والمجتمع العصري، وإنما من خلال "التفكير الحداثي" و"المعاصر" في النظرة إلى الإنسان، والآخر، والجمال، والمنافسة، والابتكار، والإبداع.
هي ببساطة كل ما يدفع في اتجاه الخير ومنفعة الوطن، إن عناصر القوة المصرية ليست "صلبة" فقط من القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية، ولكنها ناعمة أيضا متمثلة في تاريخها وجغرافيتها وفكرها وإعلامها وفنونها وأدبها ومتاحفها.
المحرك السابع هو القيام بثورة تشريعية كبرى، فواحد من أهم معوقات التنمية المصرية خلال العقود الماضية كان كثرة التشريعات والقوانين واللوائح التي تعدت عشرات الألوف، وتضاربها وتعقيدها وعدم مسايرتها أداء الأعمال والاستثمارات، وحاجتها المستمرة إلى نظام إداري معقد ومزدحم يكون مصالحا، خاصة كثيرا ما تكون متعارضة مع المصالح العليا للدولة.
المحرك الثامن هو أحد الأعمدة المهمة للسير في اتجاه الحداثة، وهو "تجديد الفكر الديني" الذي بات واحدا من أهم ملامح عهد ما بعد ٣٠ يونيو؛ حيث لم يحدث ما يماثلها منذ قيام ثورة ١٩٥٢، وفيما قبلها كانت هناك معارك ثقافية حول كتب حاولت المحاولة، ولكن الواقع كان يقود إلى الكثير من السلفية وفكر الإخوان المسلمين.
المحرك التاسع هو نتيجة منطقية للفكر الحداثي الذي يؤدي إلى قدرة المجتمع على احتواء ومشاركة جميع الجماعات الموجودة فيه، فيكون للمرأة والمسيحيين وجميع الجماعات المتميزة في المجتمع مكانها وعطاؤها على طاولة المشاركة السياسية والفكرية للدولة.
المحرك العاشر يعيد تركيب الخريطة الإدارية المصرية من جديد، فإذا كانت مصر سوف تنتشر من النهر إلى البحر، وتخترق مساحاتها الشاسعة؛ حيث تتصاعد حجم المساحة المأهولة سكانيا منها، فإن الخريطة الحالية للمحافظات المصرية لم تعد مناسبة، نتيجة ذلك كله أن "محرك" اللامركزية" و"الحكم المحلي" بات ضرورة لتكثيف حركة الاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والقومية.
لم تكن مصر لا غائبة ولا مشلولة، ولكنها كانت تعمل من أجل تغيير واقعها، واللحاق بالعصر الذي تعيش فيه.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة