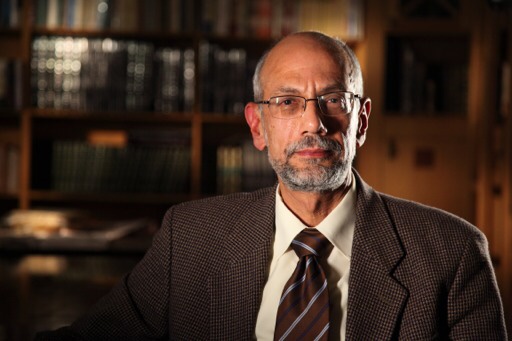قبل أن أكتب، وقبل أن تقرأ علينا أن ننتبه إلى حقيقة أن الأسماء المذكورة ليست أكثر من أمثلة لمئات، وربما آلاف من الحالات المشابهة
قبل أن أكتب، وقبل أن تقرأ علينا أن ننتبه إلى حقيقة أن الأسماء المذكورة في هذا المقال ليست أكثر من أمثلة لمئات، وربما آلاف من الحالات المشابهة، التى نعرف أو لا نعرف. فالظلم واحد. ونسأل الله ألا يجعلنا، بإغفال اسم هذا أو ذاك في زمرة الظالمين.
في التاسع من يناير الماضى، وقف رئيس الجمهورية ليعلن نصا: «.. قررت أن يكون العام ٢٠١٦ عاما للشباب المصري»، وكان طبيعيا، في دولة مثل مصر أن يحتل التصريح مانشتات الصحف الصادرة في اليوم التالي.
ثم كان في الأول من فبراير «أى بعد ثلاثة أسابيع لا غير» وبعد ما كانت مصر كلها قد استمعت إلى هتافات استاد مختار التتش أن أجرى الرئيس مداخلة تليفزيونية ليقول لنا نصا: «أنا بقول بوضوح احنا اللى مش عارفين نتواصل مع الشباب، احنا اللى مش عارفين نوجد مساحات تفاهم» (!)
ثلاثة أسابيع لا غير بين التصريحين؛ الاحتفالي والقَلِق. وبينهما «أو على هامشهما» كثيرٌ جدا من الحقائق التى إن تغافلنا عنها ستكون النتيجة «المنطقية» أن يفسح الاحتفالُ مكانه للقلق.. ومن ثم ما بعد القلق.
•••
كيف جاء «عام الشباب» هذا على شباب هذا البلد؟ أو كيف هو حال الشباب في ما رأت الدولةُ أن يكون «عامهم»؟
السؤال جاء على لسان طالب جامعي استوقفني قبل أيام في معرض الكتاب، وقبل أن ينتهى من سؤاله، كانت بعض الإجابة الصادمة (والصادقة) قد جاءت على لسان من تجمعوا من أقرانه. أذكر جانبا منها هنا، وأضيف إليها ما قد تسمح به المساحة
في «عام الشباب» هذا، وبالأحرى في الأسبوع الأول منه، وعلى باب الكاتدرائية عشية عيد الميلاد، نقلت لنا الأخبار نبأ القبض على محب دوس (٢٧ سنة) عضو تنسيقية ٣٠ يونيو، بتهمة الانضمام إلى حركة ٢٥ يناير (كما يقول نص الخبر المنشور) والمثير أن يحدث هذا قبل يومين فقط من «كلام» الرئيس المتكرر عن العلاقة بين ٣٠ يونيو و٢٥ يناير. وكالعادة يشكو محامي الشاب أنه (مثل غيره من محاميي الحالات المشابهة) لم يُمَكن من الاطلاع على التحقيقات الخاصة بموكله (!)
في عام الشباب هذا نقرأ (ما يصعب تصديقه، لولا أننا لم نسمع أن تحقيقا قد جرى فيه) عن شابين أحدهما قاهري والآخر من بني سويف أُعلن عن مقتل كل منهما بعد أن ألقي القبض عليهما بما يزيد عن الأسبوع (حسب ما تقوله الرواية «المنشورة»، التى تمنيت أن أقرأ لها تكذيبا رسميا «موثقا»)
في عام الشباب هذا، يرفض طبيب شاب التزوير في شهادة رسمية، فيكون جزاؤه أن سحله رجال السلطة بعد أن أوسعوه ضربا.
ثم كان (كما تقول الرواية المنشورة) أن وضع أمين الشرطة حذاءه على رأس الطبيب إمعانا في إذلاله وتباهيا بسلطان القوة ونفوذها.
والأدهى أن نسمع بأنه بدلا من أن تعيد الدولة الحق للطبيب وزملائه، تجبرهم على بلع الإهانة « والانصياع» للأوامر.
وبدا فيما نشر حول الموضوع، وكأن هناك من قرأ المادة ١٨ من الدستور التى تتحدث عن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ولم يقرأ المادة ٥١ من الدستور ذاته التى تنص على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها».. إلى آخر مواد الباب الثالث الخاصة بالحقوق والحريات.
المفارقة أن الذين انبروا للدفاع عن «توفير الرعاية الصحية للمواطنين» لم يترددوا في إلقاء القبض على الدكتور طاهر مختار؛ عضو نقابة الأطباء بعد أن «ضبطوا» في منزله مطبوعات مهنية تتحدث عن «الحق في الصحة في أماكن الاحتجاز»، فوجهوا له تهمة «الدعوة لقلب نظام الحكم» (!)، كما لم يترددوا في إلقاء القبض على الشاعر الشاب الدكتور أحمد سعيد عندما عاد (إلى وطنه) في زيارة قصيرة من ألمانيا التي يعمل بها جراحا للأوعية الدموية. بعد أن وجهوا له تهمة «تكدير السلم العام».
في عام الشباب هذا، نسمع عن شاب مصري اسمه عاطف بطرس.
إذا قرأت له أو عنه، ستعرف أنه من هؤلاء الذين من المفترض أن «تفخر بهم بلادهم». ثم كان أن عرفنا أن سلطات مطار القاهرة رفضت دخوله، فيما قيل أنه قرار (يصعب تصديقه) بمنع دخوله البلاد «مدى الحياة».
كانت الأنباء ليلة وصوله عن ما جرى معه في المطار متضاربة.
وعندما سألني ليلتها مراسلٌ لإحدى الصحف الأجنبية عن رأيى فيما جرى، تمهلت انتظارا لأن يقول لنا أحد المسؤولين «ماذا جرى بالضبط»، إلا أن ذلك كالعادة لم يحدث أبدا.
رغم حقيقة أن المعلومات «الصحيحة» هى السبيل الوحيد لبناء مجتمع صحى. ثم كان أن علمنا أن الأكاديمي الشاب جرى إبعاده فعلا، بعد أن قضى ليلته في انتظار طائرة أخذته إلى ألمانيا.
رفضت جهة أمنية لا نعرفها بالضبط أن يدخل الباحث الجاد إلى مصر، وكانت جهات أمنية؛ لا نعرفها أيضا قد منعت على مدى عام انقضى ما يصل عدده إلى ٥٤ مصريا (أغلبيتهم الساحقة من الشباب) من السفر إلى الخارج، دون سند «واضح» من القانون، وبما يبدو انتهاكا صارخا لنص المادة ٦٢ من الدستور والتي قضي بأن «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون»
في عام الشباب هذا، وفى واقعة لم تكن الأولى للأسف اضطرت باحثة متفردة (د. بسمة عبدالعزيز) أن تسحب أطروحتها الأكاديمية التى كانت قد تقدمت بها لنيل درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية بعد أن خشيت دوائر «جامعية» ما كان في الرسالة من «موضوعية» لن تتحملها ثقافة «الصوت الواحد» (نشرت الباحثة أطروحتها «المجهضة» في كتاب مهم عن «خطاب الأزهر وأزمة الحكم» يستحق أن يكون موضوعا لمقال قادم).
في «عام الشباب» هذا حدث ولا حرج عن ما يحدث في الجامعات التى من المفترض أنها «مصنع شباب المستقبل» من سطوة أمنية تدمر الحريات الأكاديمية والبحث العلمى، وتجفف الفكر «الحر المعلن» مما لا يدع مجالا إلا لفكر منغلق سرى، في تكرار بائس لما جرى في السبعينيات من القرن الماضى. فضلا عن إزاحة كل ماهو نبيل من قيم «أكاديمية»، تترك مكانها قسرا لقيم الدولة البوليسية من خوف ينتج رياء ونفاقا لم يعد غيرهما سبيلا ليس فقط للترقى، بل وأحيانا للحصول على الحقوق.
في «عام الشباب» هذا، تمنع «الدولة المذعورة» أكاديمية شابة «خلود صابر»؛ المدرس المساعد بآداب القاهرة من استكمال دراستها للدكتوراة في بلجيكا.
في «عام الشباب» هذا لا تتحمل السلطة أن يختار طلبة الجامعة ممثليهم بحرية، (خارج «القوائم الأمنية») فتلتف الإدارة على نتيجة الانتخابات الديموقراطية. ولا يدرك صاحب القرار، (أو من أملاه) خطورة أن يترسخ لدى هذا الجيل مفهوم أن طرق التعبير «السلمى» مسدودة، مما يفسح الطريق واسعا أمام طرق أخرى ليست في صالح المستقبل أو الاستقرار أو المجتمع.
في عام الشباب هذا، ما أن اختيرت الأصغر سنا (مايا مرسي) لتكون رئيسا للمجلس القومي للمرأة، حتى خرج علينا من يتهمها بأنها قادمة من «الأمم المتحدة» لتنفيذ أجندة / مؤامرة المنظمات الدولية. وكأن مصر (الدولة) ليست عضوا رسميا بتلك المنظمات الدولية (!). فيما بدا وكأنه
هجمة استباقية تعتمد منطق «ادبح لها القطة» حتى لا تفكر الشابة القادمة من خلفية دولية في استقلال لم يعتده، ولا يرغب فيه «الدولتيون». وهو الأمر الذى نعرف له سوابق عدة للأسف.
في عام الشباب هذا، تتواصل حملة التشويه الممنهج لعصام حجي؛ العالم المصرى «الشاب» الذى وصل إلى مكانته العلمية المرموقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لا لسبب إلا لأنه وقف ذات يوم أمام أكذوبة «العصا السحرية لعلاج الإيدز وفيروس سي» التى روج لها البعض قبل عامين.
في «عام الشباب» هذا لا يتردد صاحب القرار في أن يلقى القبض على إسلام جاويش؛ رسام الكارتون المبدع الشاب، وبغض النظر عن أن النيابة قد أفرجت عنه في النهاية بلا ضمان، إلا أن المفارقة التى استوقفت الشباب كانت في نص بيان الداخلية الرسمى الذى جاء به «كما تبين أن المذكور يدير موقعا خاصا به على شبكة المعلومات الدولية» (!)، كما جاء به أيضا أن «التحريات أفادت باستخدام الشبكة في بث أخبار دون تصريح» (!) فيما بدا وكأن هناك من لم يسمع عن حقيقة أن هناك أكثر من ٢٢ مليونا من المصريين لهم صفحات على الإنترنت، وأن الملايين منهم (كما في العالم كله) ينشرون أخبارا كل ثانية.
•••
في عام الشباب، تكتمل جهود الدولة «الذكية» في دفع الشباب الذين كانوا قد خرجوا عن الإخوان المسلمين للعودة بحماس إلى صفوف الجماعة بعد ما رأوه من عنت وظلم يقع عشوائيا على أهاليهم وأصدقائهم.
في «عام الشباب» هذا بدا وأن الدولة «الذكية» أيضا لم تكتف بمعاقبة الشباب، الذى لا يعرف «السمع والطاعة» بل آثرت أن تعاقب من تجرأوا يوما فتصدوا لتربيتهم على الاعتدال ونبذ التطرف والعنف. هل سمعتم عن هشام جعفر (المحبوس، كما العديدين غيره بلا محاكمة)؟ كان واحدا ممن وقفوا بجهودهم وراء إصدار «وثيقة الأزهر للحريات» المدافعة عن حقوق المرأة وحرية العقيدة، والنابذة لأفكار متطرفة كانت قد تسربت لمجتمعنا منذ سبعينيات القرن الماضي. هل قرأتم أبحاثه المتعمقة في نقد الفكر الجامد لجماعة الإخوان وتنظيمها وفلسفة خطابها؟ هل عرفتم بمشروعه «إسلام أون لاين» الذى حاربه الإخوان في ٢٠١٠ حتى نجحوا في إجهاضه؟ هشام هذا محبوس بلا محاكمة، ولكن بتهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين (!)
تتحدث الدولة «الرسمية» عن عام للشباب الذين «ننتظر منهم ألا يبخلوا بجهودهم في العمل لوطنهم»، ولكن الدولة ذاتها لم تتردد يوما في معاقبة المهندس الشاب هاني الجمل الذى ترك جامعته العالمية المرموقة ليعود إلى مصر يشارك في بناء مستقبلها بأنشطة تطوعية (راجع الرابط)، فكان نصيبه الحكم بالسجن المشدد عقابا على «وقفة احتجاجية سلمية» لم يحمل فيها سلاحا، ولم يحاصر مديرية للأمن كما فعل أمناء الشرطة في الشرقية قبل أشهر.
أفرج في نهاية المطاف عن هاني بعد أن قضى خلف القضبان ما يقرب من العام، ولكن الصغيرة «آية حجازي» خريجة الجامعة الأمريكية، وزوجها محمد حسانين، وخمسة «شباب» آخرين هم: شريف طلعت، وأميرة فرج، وإبراهيم عبدربه، وكريم مجدي، ومحمد السيد مازالوا رهن الحبس الاحتياطى رغم مرور ما يزيد عن ٦٠٠ يوم. وكان الشباب الصغار قد تجرأوا فحلموا بمشروع يعمل على تقديم حياة كريمة لأطفال الشوارع ليتحولوا من مشاريع مجرمين إلى قوى منتجة في المجتمع. إلا أن محاولتهم «التطوعية» تلك والتى بدا أنهم احتذوا فيها بتجربة نبيل الحركة الطلابية في السبعينيات «أحمد عبدالله رزة» قادتهم في النهاية إلى السجن. (القصة كاملة نشرها بيان من ٢٥ منظمة حقوقية تجده على هذا الرابط)
ليالي السجن الستمائة التي قضتها آية حجازي وزملاؤها، وصلت إلى ما يزيد عن السبعمائة في حالة محمود محمد (٢٠ سنة) وإسلام طلعت (٢١ سنة) اللذين ألقيا في السجن منذ عامين بعد ضبطهما يرتديان «تي شيرت» مكتوب عليه «لا للتعذيب»، حسب ما تقول القصة المشهورة. كما وصلت إلى ما يتجاوز الثمنمائة يوم في حالة المصور الصحفي محمود شوكان (٢٧ سنة) الذي تصادف أنه كان «يمارس مهنته»!
عن هؤلاء الشباب، وصبيحة الإعلان عن «عام الشباب» خرجت علينا صحف التاسع من يناير، فيما بدا «استباقا» لذكرى الثورة بخبر مفاده أن «الرئيس سيصدر خلال الأيام المقبلة قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض الشباب المسجونين»، ثم لم تمر أيام إلا ويخرج علينا المتحدث الرسمى
لوزارة الداخلية ليوضح إنه لم ترد إلى الوزارة أية قرارات بصدور عفو رئاسى عن بعض المساجين، مشيرا إلى أنه صدر قرار بالعفو فقط عن الذين أمضوا نصف المدة في قضايا «جنائية»! (انظر القرار الجمهورى رقم ١ لسنة ٢٠١٦ واستمع لتصريحات مساعد وزير الداخلية لشريف عامر).
لن أمل من التذكير بما نسبته الصحف إلى الرئيس (٢٤ يونيو ٢٠١٥) أنه قال: «هناك مظلومون داخل السجن، وقرار العفو اﻷخير ليس معناه أن اللى جوه كلهم مش مظلومين».
ولن أمل من التأكيد على ما ذكرته في تغريدة يومها: «جميل أن يخرج ولو مظلوم واحد من سجنه، ولكن الأجمل أن يخرج كل المظلومين. أما الأفضل من هذا وذاك هو ألا يكون لديك نظام يسمح أصلا بحبس المظلومين».
.....
ارجعوا من فضلكم إلى تصريح السيد الرئيس، وراجعوا من فضلكم علماء النفس والاجتماع، أو ما تعرفونه من منطق. ثم اسألوا أنفسكم: ماذا يفعل الإحساس بالظلم والغبن والإحباط بأصحابه. وكيف يتحول كل ذلك طبيعيا إلى «قنابل موقوتة» تنفجر فينا قبل أصحابها؟
أتعرفون ماذا يفعل الإحباط؟
قبل أن تكتفوا بالنظر تحت أقدامكم، ارجعوا إلى تفاصيل قصة طالب الهندسة حسن بشندى، الذى فجر نفسه في شارع الأزهر المزدحم بالسائحين والباعة الجائلين (أبريل ٢٠٠٥).
ثم وقبل أن تخدعوا أنفسكم بأنكم غسلتم أياديكم، برجم أحمد مالك (٢٠ سنة) وشادى حسين (٢٣ سنة) أرجوكم كلفوا خاطركم إن كُنتُم جادين فاقرأوا ما كتبوه على مواقع التواصل الاجتماعى لتعرفوا ماذا يفعل الإحباط بأبنائكم. ولتعرفوا إلى أين ينبغى أن توجهوا أصابع الاتهام.
•••
ولأن «الحقائق لا تنفى بالضرورة بعضها» كما يقول المناطقة، وجب الانتباه (دون إفراط أو تفريط) إلى أنه لا يتعارض مع كل ما سبق، كما لا ينفيه حقيقة أنه في «عام الشباب» هذا يتواصل أيضا للأسف نزيف الدم الطاهر، لتفقد مصر عشرات من شبابها «وأبنائنا» العسكريين (جيشا وشرطة)، إلى جانب غيرهم من المدنيين في «حرب» حذرنا مبكرا من أن في أسلوب إدارتها ما قد يزيدها اشتعالا «وضحايا» لدوائر ثأر، هى ككل الدوائر لا تنتهى.
•••
في دراسة مهمة صدرت عام ٢٠٠٩ (قبل الربيع العربي) عن معهد بروكينجز وكلية دبي للإدارة الحكومية توصيف لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي، كان من شأنه في نهاية المطاف أن يؤدي إلى ما شهدته المنطقة من انفجارات في نهاية ٢٠١٠ بداية ٢٠١١. الدراسة التي حملت عنوان «شباب الشرق الأوسط ـ جيل يترقب ووعود لا تتحقق» Generation in Waiting: The Unfulfilled Promise of Young People in the Middle East تذكرنا بأن أن أغلبية السكان في منطقتنا تحت عمر الثلاثين. وبأن أغلبيتهم يعانون الفقر والتهميش. وبأن «النظم» السائدة في دول المنطقة فشلت في ضمان حصول الشباب على فرص حقيقية في المشاركة في صنع حاضرهم ومستقبلهم.ورغم ما بدا استغراقا من محرريه بحكم تخصصاتهم في الجانب الاقتصادي يتحدث الكتاب (الصادر في ٢٠٠٩) أيضا عن إحساس متعاظم لدى الشباب بغياب الحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى مسؤولية النظم الحاكمة عن ذلك، وكأنه كان، استباقا يقرأ شعارات الثورات العربية المجهَضة: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية / الشعب يريد إسقاط النظام»
•••
وبعد..
فربما كان من «السهل» أن نكتب هنا قصصا لا تنتهى لهذا أو ذاك تداول الناس أسماءهم على مدى العامين الماضيين، ولكن يظل «الرقم الصعب» والأكثر أهمية أن هذا ليس أكثر من قمة جبل الجليد الغاطس، وأن قائمة الشباب المظلومين والمحبطين أو المهجرين أو منفيين قسرا أطول بكثير جدا مما نعرف. وأن «الثمن» أفدح بكثير جدا مما نظن. وأن بلدا هذا حال شبابه، «لا يصح» أن نتحدث فيه هكذا عن مستقبل.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة