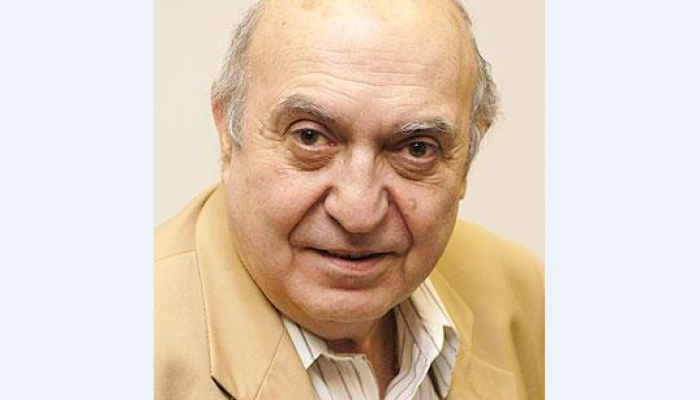بين «الوتد» الروسي و«الوتد» الإيراني و«الوتد» التركي و«الوتد» الداعشي و«الوتد» الكردي... أي أرض عربية بقيت لدولة «قلب العروبة النابض»؟
جاء إلى البيت الأبيض مصممًا على النأي بالولايات المتحدة عن أي «تورط» عسكري في الشرق الأوسط... وخرج منه معترفًا بأن القوة الغاشمة لا تزال سيدة الأحكام في هذا العالم، وأنه لا مكان للمثالية في السياسة، إن هي وضعت في خدمة مصلحة معينة.
لو اقتصرت سيرة الرئيس باراك أوباما على هذه المعطيات فحسب، لهان بعض الشيء التأسف على وضع الشرق الأوسط. ولكن «طوباوية» أوباما السياسية استتبعت انسحاب النفوذ الأميركي السياسي من المنطقة، وحلول النفوذ العسكري الروسي محله، وبأسلوب يؤكد أن القوة الغاشمة ما زالت البديل المعتمد دوليًا للدبلوماسية في قرننا الحادي والعشرين.
بين شرق أوسط فشلت الذهنية الأنغلو - ساكسونية في غرس مفهومها الديمقراطي فيه، ونجحت الذهنية السلافية في تثبيت مفهومها الأوتوقراطي، تواجه دول المنطقة مستقبلاً مثقلاً بتركة مرهقة من دبلوماسية أوباما الانزوائية: دول أزال «الداعشيون» حدودها الجغرافية، ولم يبقَ منها سوى اسم على غير مسمى، و«ضيف» أجنبي فاته عصر الاستعمار الذهبي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فوجد في حلب فرصته لتقديم أوراق اعتماده «قيصرًا» جديدًا على المنطقة، و«جار» إقليمي توسل العصبية المذهبية ليقضي على ما تبقى من حس قومي في المنطقة، ويمد نفوذه إلى كل زاوية تطالها ميليشياته.
سوريا اليوم أشبه ما تكون بالغرب الأميركي في القرن التاسع عشر، أي غداة إقرار قانون التملك المجاني لأراضيه الشاسعة، في العام 1862 (Homestead Act). آنذاك، كان يكفي لأي مستوطن أوروبي أن يغرس وتدًا يحمل اسمه في أي قطعة أرض يرغب في تملكها، لتسجل باسمه، لاحقًا، في الدوائر العقارية.
إلا أن الفارق الكبير بين سهول الغرب الأميركي في القرن التاسع عشر والساحة السورية في القرن الحادي والعشرين، أن مستوطني الغرب الأميركي كانوا أفرادًا يخضعون لقوانين دولتهم، فيما «مستوطنو» الساحة السورية دول أجنبية تعمل لمصالحها الخاصة في المنطقة.
بين «الوتد» الروسي و«الوتد» الإيراني و«الوتد» التركي و«الوتد» الداعشي و«الوتد» الكردي... أي أرض عربية بقيت لدولة «قلب العروبة النابض»؟
أوتاد الآخرين في سوريا، على كثرتها وتنوعها، قد لا تنزع دون تفاهم أميركي - روسي على تقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط الجديد. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق قد يكون: هل يكفي إعجاب دونالد ترامب الشخصي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي تغض «المؤسسة» الأميركية، خصوصًا البنتاغون، النظر عن تبعات الوجود الروسي في الشرق الأوسط، وأبعاده المستقبلية؟
حتى الآن على الأقل، لم يصدر عن الرئيس الأميركي المنتحب أي موقف سياسي واضح حيال ما يخطط له في الشرق الأوسط، باستثناء الإعراب عن دعمه (الطبيعي) لإسرائيل، واقتراحه التعاون مع روسيا في مواجهة «دولة الخلافة الإسلامية» المزعومة، واقتراحه إقامة «مناطق آمنة» في سوريا، وهو اقتراح أسقطته روسيا عسكريًا في تعاملها مع حلب وكأنها غروزني أخرى.
رغم كل التطورات العسكرية الأخيرة، من المبكر بعد إجراء جردة نهائية «لحرب الآخرين» على أرض سوريا. ولو جاز تقويمها بمنظور محض عسكري، جاز اعتبارها نصرًا مكلفًا للنظام، ولكنها تبقى، بأي تقويم سياسي مستقبلي، نكسة - مكلفة أيضًا - لعروبة «قلب العروبة النابض»... وربما مقدمة لإعادة صياغة كيانه الجغرافي.
* نقلا عن الشرق الأوسط
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة